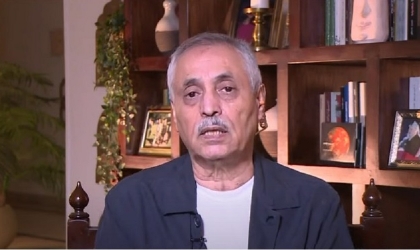هل يجب تعديل الدستور؟

عبد الفتاح الجبالي
من المعروف أن الدساتير وُلدت لتبقى لعقود طويلة، لأنها تمثل العقد الاجتماعى بين المجتمع والسلطة. من هنا فالدفاع عن الدستور يعد فرض عين على كل مواطن ومواطنة. وكما ذكر جان جاك روسو فى كتابه «العقد الاجتماعى» أن الدستور شرعى لأنه قائم على أساس العقد الاجتماعى، وهو عادل لأنه يطبق على الجميع، ونافع لأنه لا يمكن أن يكون له غرض إلا الخير العام، ومتين لأنه مضمون بالقوة العامة والسلطة العليا.
ولكن وعلى الجانب الآخر فإن الدستور عمل بشرى يمكن أن يصيبه ما يصيب البشر من أخطاء يجب العمل على تلافيها دون المساس بالمبادئ الأساسية والقيم الحاكمة له، ولذلك فقد أحسن الدستور صنعاً حين فتح الباب لإمكانية التعديل وفقاً للمادة 226 والتى سمحت بتعديل مادة أو أكثر من مواده مع بيان أسباب التعديل.
وتأتى أهمية هذه المسألة فى ضوء ما أشار إليه المفكر الاقتصادى الهندى والحائز على جائزة نوبل «امارتيا صن» فى كتابه المعنون «التنمية حرية» Development as Freedom وهى المسألة الجوهرية التى طالما غابت عن العديد من الباحثين والمحللين، إذ أشار إلى «أن التنمية هى عملية توسيع فى الحريات الحقيقية للناس، وبالتالى فهى ليست فقط نمواً فى الناتج أو زيادة فى الدخول ولكنها بالأساس توسيع نطاق الحريات التى يتمتع بها الأفراد والحقوق السياسية والمدنية وحق التعبير والاختيار جنباً إلى جنب مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية»
من هذا المنطلق تأتى أهمية المرحلة الحالية التى يمر بها المجتمع المصرى بغية الانطلاق إلى آفاق أوسع للتنمية وإنجاز الخطط التنموية. ووضع البلاد على الطريق الأصعب والأهم وهو بناء مصر الحديثة التى نصبو إليها جميعاً.
وقد أثبتت الدراسات العلمية العديدة أن البلدان التى تتمتع بحريات سياسة واسعة ومناخ ديمقراطى سليم، مع استبعاد أثر المتغيرات الأخرى، قد حققت نجاحات فائقة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين عامة، وتوفير الاحتياجات الأساسية من تعليم وصحة للسواد الأعظم من الجمهور. فالديمقراطية تضمن المشاركة الفعّالة من جانب كافة فئات المجتمع فى صنع القرار والرقابة عليه، وهو ما يتطلب بدوره المعرفة الكاملة بالأوضاع المالية والاقتصادية بالبلاد، وبالتالى الشفافية المطلقة فى عرض كافة الأمور الاقتصادية على البرلمان والمجتمع المدنى ليس فقط للأغراض الاقتصادية ولكن، وهو الأهم، من أجل المزيد من المساءلة السياسية أمام السلطات الرقابية والتشريعية والشعبية. ولذلك تعد الديمقراطية وما تتطلبه من شفافية مطلقة من العوامل الضرورية التى تمكّن مجلس النواب والمواطنين بوجه عام من مراقبة الحكومة ومحاسبتها. وهو ما يساعد كثيراً على تحسين الأداء وإصلاح السياسات والبرامج التنموية المطبقة والسير فيها فى الطريق السليم الذى يحقق مصلحة المجتمع والأفراد.
ولذلك أشارت التجارب الدولية المختلفة إلى أهمية التلازم بين الديمقراطية والتنمية، باعتباره شرطاً أساسياً للنجاح، فمعظم التجارب التنموية التى نجحت لدى العديد من البلدان قد ارتبطت أساساً بتدعيم آليات المشاركة الشعبية والديمقراطية والشفافية وتطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة عند وضع السياسات المختلفة، ولم تقتصر فقط على بعض الإجراءات والعمليات المتعلقة بصندوق الانتخابات ولكنها تعدّتها لتشمل جوانب هذه العملية كافة. وبعبارة أخرى فإن التنمية الحقيقية تتطلب بالضرورة وجود حزمة من القوانين المدنية والتجارية والجنائية الواضحة والمعلن عنها بالقدر الكافى مع ضمان إنفاذها عن طريق جهاز قضائى مستقل، فضلاً عن تعزيز النظام الضريبى والإدارة الضريبية وزيادة شفافية المالية العامة وتفعيل إجراءات المحاسبة المالية وتطوير الجهاز الإدارى للدولة مع تفعيل المنافسة وغيرها من الأمور الضرورية للاقتصاد.
من هذا المنطلق نرى ضرورة تعديل المسار الاقتصادى الراهن والسير به فى الاتجاهات التى تستطيع علاج الاختلالات الأساسية فى بنية الاقتصاد القومى والمشكلات الاقتصادية الراهنة وعلى رأسها التضخم والبطالة والانتقال إلى المرحلة الأهم التى نركز فيها على قضايا الإنتاج والإنتاجية من خلال التوسع المنظم والفعال فى بناء القواعد الإنتاجية وتعبئة الموارد المحلية واستخدامها أفضل استخدام ممكن. وذلك عن طريق إيجاد بيئة اقتصادية قوية ومستوى صناعى معقول ونمو زراعى يساعد على تلبية الاحتياجات الأساسية. والاستفادة المثلى من الطاقات المتاحة وذلك بغية رفع مستوى المعيشة. وكلها أمور لا تتم إلا فى إطار ديمقراطى حقيقى يضمن الرقابة الكاملة على أعمال الحكومة والشفافية المطلقة فى جميع التصرفات والقوانين والقرارات المنظمة.
وهو ما أكدته الدراسات التى تناولت التجارب الإصلاحية التى شهدتها الفترة منذ تسعينات القرن العشرين والتى شهدت العديد من الإصلاحات غير المسبوقة فى التاريخ الاقتصادى من حيث نطاقها واتساعها وعمقها. وقد خرجت الدراسات بنتيجة أساسية مفادها أن عملية النمو معقدة للغاية ولا تخضع للصيغ والمعادلات البسيطة وهناك العديد من الدروس وعلى رأسها أنه يجب إخضاع الحكومات للمساءلة وليس تجاوزها وبالتالى يجب التركيز على تحسين أساليب الموازنة والمراقبة على السلطات الحكومية وإيجاد الظروف التى تؤدى إلى تحسين صنع القرار. كما يجب البعد عن أسلوب صنع القرار المقولب، أى يجب إدراك الخصائص المميزة للدولة والقيود الملزمة للنمو، وهو ما يشير إلى أن تحريك عملية الإصلاح الاقتصادى، إلى ما هو أبعد من وضعها الحالى، يتطلب بالضرورة حواراً جاداً ومكثفاً حول هذه القضايا وإعادة تعريف العقد الاجتماعى مما يسهم كثيراً فى إحياء الحياة السياسية المصرية.
كل هذه الأمور وغيرها توضح لنا بجلاء أهمية النقاش حول ما يحتويه دستور البلاد من مبادئ أساسية التى تمكن المجتمع من تحقيق الأهداف السالفة الذكر.
أولاً: الموازنة العامة للدولة والشفافية
من المعروف أن الغرض الأساسى من إعداد الموازنة هو تحقيق نوعين من الرقابة، الأولى دستورية، والثانية اقتصادية ومالية. ومن حيث الوظيفة الأولى تعد الموازنة وثيقة سياسية وقانونية تخدم أهداف الرقابة الدستورية وتضمن المشاركة الفعالة من جانب فئات المجتمع كافة. وهو ما يتطلب بدوره المعرفة الكاملة بالأوضاع المالية وبالتالى الشفافية المطلقة فى عرض بنود الموازنة ليس فقط للأغراض الاقتصادية، ولكن وهو الأهم من أجل المزيد من المساءلة السياسية أمام السلطات الرقابية والتشريعية والشعبية، إذ تعد الرقابة على المال العام أحد الأدوار الأساسية المميزة لكافة المجتمعات الحديثة، بل إن نشأة البرلمانات أساساً جاءت لتحقيق هذه العملية، وكلنا نتذكر المقولة الأساسية «لا ضرائب دون تمثيل» والتى جاءت فى أعقاب «الماجنا كارتا» أو العهد العظيم فى أوائل القرن الثالث عشر والذى نص على ضرورة أن يدعو الملك المجلس الكبير للمملكة للاجتماع فى أوقات معينة وأماكن محددة ولأغراض منوه عنها، ولتقرير المصروفات والإيرادات. كما أنه لا يجوز فرض ضريبة دون موافقة المجلس العام للمملكة» وهى الخطوة التى تعد وبحق الأولى نحو تحقيق الحكومة البرلمانية.
من هنا كان من الضرورى العمل على تدعيم وتعزيز الرقابة المالية بصورة تجعلها قادرة على الحيلولة دون العبث بالمال العام أو إهداره. ولهذا شهدت الآونة الأخيرة اهتماماً متزايداً على كافة المستويات النظرية والعملية، وكذلك فى مختلف الدول المتقدمة والنامية، بعملية صنع الموازنة ومدى الشفافية التى تتمتع بها من جهة، وبكفاءة إدارة المالية العامة وبصفة خاصة إدارة الإنفاق العام والدين العام من جهة أخرى. لهذا طوّر صندوق النقد الدولى من المعايير الخاصة بشفافية الموازنة العامة للدولة وكذلك أدخل البنك الدولى العديد من التغييرات المهمة فى برنامج الإنفاق العام والمحاسبة المالية، ناهيك عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى التى قامت بمراجعة المعايير الخاصة بإدارة المالية العامة.
فى هذا السياق يمكننا مناقشة المواد الخاصة بالموازنة العامة للدولة كما جاءت فى دستور 2014، وهنا تشير المادة 224 إلى أن الموازنة العامة للدولة تشتمل على كافة الإيرادات والمصروفات دون استثناء، ووفقاً لهذه الصياغة فإن ما يعرض على البرلمان هو القسم الأول من الموازنة فقط دون الأقسام الأخرى، فالموازنة عبارة عن استخدامات وموارد، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية؛ القسم الأول منها يُعنَى بحركة المصروفات والإيرادات المتعلقة بتشغيل دولاب العمل الاقتصادى، ويتناول هذا الجزء المصروفات العامة (وهى ستة أبواب هى الأجور وشراء السلع والخدمات والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخرى والاستثمارات) والإيرادات العامة (وهى ثلاثة أبواب تشمل الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى)، وهو ما ينجم عنه العجز أو الفائض النقدى. والقسم الثانى يتعلق بحيازة وبيع الأصول المالية، وبإضافة محصلة هذه العمليات نحصل على العجز أو الفائض الكلى ثم القسم الثالث يتعلق بطرق تمويل العجز فى الموازنة.
ووفقاً لذلك فإن الموارد ليست كلها إيرادات، إذ إن الإيرادات هى التى لا تنشئ التزاماً بالسداد، فالضرائب تعد من الإيرادات، أما القروض فهى لا تعد من الإيرادات ولكنها تدخل ضمن موارد الموازنة. وبالمثل ليست كل الاستخدامات مصروفات، فسداد أقساط القروض لا يعد مصروفاً لأنه نتيجة لالتزام سابق نشأ حين تسلمت الحكومة القرض، غير أن مدفوعات الدين تعتبر مصروفاً.
ومن هنا فإنه لتقييم الوضع المالى للدولة، عند نقطة زمنية معينة، يجب التزام الحذر بشكل خاص فى تفسير الإيرادات أو المصروفات التى تنشأ من التغييرات فى وضع صافى ثروة الدولة. وهى تفرقة مهمة وضرورية. وبالتالى فإنه كان من المفترض أن ينص الدستور على أن تعرض الموازنة (موارد واستخدامات) وليس (مصروفات وإيرادات) كما جاء فى النص السالف الإشارة إليه.
ومن المشكلات الجوهرية فى الدستور الحالى إغفاله الحديث تماماً عن حالة عدم الاتفاق على مشروع الموازنة والموقف منه، وذلك على العكس مما سارت عليه الدساتير السابقة التى كانت تنص على أنه فى حالة عدم اعتماد الموازنة قبل بدء السنة المالية الجديدة يتم العمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتماد الجديدة، وهو نص ضرورى ومهم يجب إعادته إلى مواد الدستور مرة أخرى.
ومن الأمور اللافتة للنظر فى هذه المادة أيضاً الحديث عن جواز تعديل القوانين القائمة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات دون أن يتم تحميل المواطنين بأعباء جديدة، وهى عبارة مطاطة لا تسمن ولا تغنى من جوع. إذ إن أى إجراء لا بد أن يترتب عليه أعباء على شرائح معينة من المجتمع، وبالتالى كان من الأفضل البحث عن عدم تحميل الشرائح الدنيا تكلفة هذا الإصلاح وليس المجتمع بأكمله.
ومن الأخطاء الشديدة فى هذه المادة أيضاً ما جاء بالفقرة الرابعة منها والتى نصت على أنه لايجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص ....الخ وهنا خلطت بين قانون الموازنة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته وقانون ربط الموازنة الذى يصدر سنوياً وهو المقصود هنا فى هذه الفقرة وليس قانون الموازنة.
ويرتبط بذلك أيضاً ما جاء فى المادة (203) والتى نصت على أن مجلس الدفاع الوطنى يناقش الموازنة، والأدق أنه يناقش مشروع الموازنة وليس الموازنة.
ثانياً: الموازنة المستقلة والاستقلال المالى
من الأمور الأخرى المرتبطة بهذه المسألة الإفراط فى الحديث عن الموازنات المستقلة والاستقلال المالى، حيث تكرر النص كثيراً على حصول بعض الجهات على موازنات مستقلة، فالمادة 178 الخاصة بالوحدات المحلية والمادة 182 الخاصة بالمجالس المحلية والمادة 211 الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وغيرها أشارت إلى حصول هذه الجهات على موازنات مستقلة، وهو لفظ عام ليس له دلالة محددة إذا كانت هذه الكيانات داخل الموازنة العامة للدولة، وهو المقصود هنا وليست موازنات خارج الموازنة العامة للدولة مثل الهيئات الاقتصادية، فتلك التى تطلق عليها موازنات مستقلة، أما داخل الموازنة العامة فإن كل جهة من هذه الجهات يعد لها موازنات مالية وفقاً للقانون المنظم لها، ويتم تجميعها جميعاً فى إطار أشمل هو الموازنة العامة للدولة.
وينطبق القول نفسه على الاستقلال المالى الذى نص عليه الدستور للعديد من الجهات، فهو أيضاً حديث غير دقيق علمياً، فمن المعروف أن هناك أسساً ومبادئ موحدة لجميع الجهات الداخلة فى الموازنة تصدر فى قانون ربط الموازنة أو التأشيرات الملحقة به ويجب على الجميع الالتزام بهذه القواعد والأسس المحاسبية والمالية.
وهنا لا يجب أن نخلط بين هذه المسألة وموازنة البند الواحد التى تنطبق على الهيئات القضائية والقوات المسلحة وفقاً للدستور، فهذه ليست موازنات مستقلة ولكنها توضع بنداً واحداً فى الموازنة لاعتبارات يراها المشرع ضرورية لأغراض الأمن القومى أو الفصل بين السلطات وعدم تغول السلطة التنفيذية على غيرها من السلطات.
بالإضافة إلى ذلك ما زالت الموازنة العامة للدولة تعانى من قيام بعض الوحدات بفتح حسابات خاصة بالبنوك يتم إيداع بعض المتحصلات بها والصرف منها خارج الموازنة بالمخالفة لمبدأ العمومية الوارد بالمادتين 3 و9 من القانون رقم 53 لسنة 1973 وكذلك الاستخدام المفرط للميزانيات التكميلية. الأمر الذى يتطلب الحد من هذه المعاملات المالية والحد من النفقات السنوية التى يرخص بها بموجب تشريعات أخرى بخلاف قانون الموازنة، خاصة أن الإقلال من المعاملات التى تتم خارج الموازنة يؤدى إلى المزيد من الشفافية ويجعل الحكومات أكثر شعوراً بالمسئولية تجاه المالية العامة وتفرض انضباطاً على صانعى السياسة وهى كلها أمور عكس ما ذهب إليه الدستور.
ثالثاً: الأجور والحد الأقصى
وثالث القضايا المهمة فى هذا المجال ما ذهبت إليه المادة 27 من الالتزام بحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر. إذ إن هذا النص يعانى مشكلتين أساسيتين؛ أولاهما أنه قصر الحد الأقصى على العاملين بأجر وبالتالى يتحدث عن الموظف العام فقط ولا يتحدث عن غير الموظف العام مثل المستشارين من الخارج. فمن المعروف أن الهدف من الحد الأقصى للأجور هو الحفاظ على المال العام وليس معاقبة العاملين بالجهاز الحكومى، إذ إنه ووفقاً لهذه المادة يصبح العاملون بدون أجر فى وضع أفضل من موظفى الدولة وهو عكس التوجه العام. وثانياً أن النص بهذه الصياغة يستثنى العديد من الجهات العامة مثل القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية والشركات القابضة النوعية المملوكة للدولة وكلها كيانات اقتصادية لا تدخل ضمن التعريف، كما جاء فى المادة المذكورة، وهو ما نجحت العديد من الجهات المشار إليها فى استغلاله والحصول على أحكام بعدم انطباق هذه المادة ومن ثم قانون الحد الأقصى على العاملين بها، وهذه التفرقة أيضاً تخالف مبدأ العدالة التى نصبو إليها جميعاً.
رابعاً: الإنفاق العام على الصحة والتعليم
ورابع الموضوعات التى تحتاج إلى إعادة نظر ما يتعلق بالمواد 18 و19 و21 و23 والتى تتعلق بالإنفاق الحكومى على مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى والتعليم العالى. وهنا توجد عدة أمور، أولها يتعلق بالحديث عن الإنفاق الحكومى وليس الإنفاق العام وبمقتضى هذه المسألة فإن الحديث يقتصر فقط على بنود الإنفاق داخل الموازنة العامة للدولة ولا يتضمن الجهات الأخرى مثل الهيئات الاقتصادية العاملة فى هذه المجالات وهى كثيرة، ففى مجال الصحة توجد هيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية بالقاهرة وكذلك بالإسكندرية والقليوبية، وفى مجال التعليم توجد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، وفى مجال البحث العلمى توجد هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وكذلك هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمعهد القومى للإدارة وغيرها من الجهات التى تعد من الإنفاق العام وليس الإنفاق الحكومى، وهو الأساس عند تقييم دور الدولة فى الإنفاق على الجوانب الاجتماعية المختلفة.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الدستور ذهب فى مواده إلى الحديث عن الناتج القومى الإجمالى، وكان الأدق هو الحديث عن الناتج المحلى الإجمالى، لأن الثانى يتضمن صافى عوائد الإنتاج فى الخارج. ولن ندخل هنا فى الجدل حول «هل من الأجدى أن تكون النسبة من الناتج المحلى أم من الإنفاق العام؟» لأن هذه مسألة خلافية لا يوجد إجماع عليها.
وفى هذا السياق أيضاً نناقش الحديث المتكرر فى الدستور عن الوصول إلى «المستويات العالمية» (كما جاء فى المواد 18، 19، 21، 23 وغيرها)، وهى عبارة مطاطة، فلا يوجد مستوى محدد للإنفاق ينطبق على جميع البلدان، إذ إن فكرة تحديد الحجم الأمثل للإنفاق العام الذى يحقق الأهداف التنموية يتوقف على طبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة، فمشكلات الإنفاق لا تنشأ فقط نتيجة لعدم ملاءمة مستوى الإنفاق وهيكله ولكن أيضاً نتيجة للمشاكل الإدارية فى السيطرة على الإنفاق، الأمر الذى يتيح للمجتمع تحديد كيفية إنفاق الموارد المحدودة بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية فى المجالات التى تحتاج إلى التدخل العام. وبالتالى يتمثل التحدى الذى يواجه الإنفاق العام فى ضمان مستوى يتسق مع الاستقرار الاقتصادى الكلى من جهة، وطبيعة الأوضاع الاجتماعية السائدة فى الدولة من جهة أخرى، ثم تجرى بعد ذلك هيكلة الإنفاق كجزء من الإجراءات التنفيذية للسياسة المالية. من هنا فإن تركيب وهيكل الإنفاق العام - لا مستواه - هو المهم من وجهة نظرنا. وهذا لا ينفى بالطبع أهمية العمل على تحقيق فعالية الإنفاق العام عن طريق ضمان التأكد من أن هذا الإنفاق يذهب فى الغرض المخصص ، فقد تتوافر الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم، مجاناً وبكميات ونوعيات مناسبة، ولكن لأسباب معينة لا يستطيع الفقراء الوصول إليها، إما لأنهم أفقر من أن يتحملوا التكاليف المصاحبة للاستفادة بهذه الخدمات (مثل فقدان الدخل) أو تكاليف الدواء أو المستلزمات المدرسية أو تكاليف الانتقال إلى مكان هذه الخدمة، وهى الأمور التى ينبغى أن تتوجه إليها الاهتمامات فى عملية الإصلاح المالى.
خامساً: القطاع غير الرسمى
نأتى الآن إلى ما ذهبت إليه المادة 28 من الدستور التى أشارت إلى أن الدولة تعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله».. وهنا نتساءل: «هل الهدف هو تنظيم هذا القطاع الحيوى والمهم، أم الأجدى للمجتمع هو تحويله إلى قطاع رسمى داخل دولاب العمل الاقتصادى؟». هذا السؤال من الأهمية فى ضوء الواقع المصرى المعيش والذى يتسم بعدم وضوح ملامح القطاع وعدم وجود تعريف مستقر عليه، وبالتالى يجب أن نفرق بين «المشروع الصغير» و«المشروع الصناعى الصغير»، فالأول يهدف إلى خفض نسب الفقر ورفع مستوى معيشة الأفراد وإيجاد فرص عمل، وهى مشروعات يندرج تحت عباءتها العديد من الأنشطة مثل تجارة التجزئة والبقالة والمخابز البلدية والمطاعم والمقاهى وقطع غيار السيارات... إلخ. أما النوع الثانى، والذى يعد وبحق الركيزة الأساسية للتنمية الصناعية، وذلك فى ضوء العلاقات التشابكية بين هذا القطاع والمؤسسات الإنتاجية الكبرى، وهو ما يعرف بالصناعات الخفيفة والمغذية والتى تكتمل بها المنظومة الإنتاجية، لهذا فإن هذا القطاع يحقق قيمة اقتصادية مضافة ويسهم فى التطوير التكنولوجى المطلوب. فعلى الرغم من هذه الإيجابيات إلا أن نمو هذا القطاع يؤدى إلى عدم الاستقرار الداخلى للاقتصاد القومى وعدم دقة المؤشرات الاقتصادية المستخدمة فى قياس الأداء الاقتصادى، ومن ثم صعوبة وضع أو رسم سياسات محددة من جانب متخذى القرار فى المجتمع، ناهيك عن صعوبة تنظيم الأوضاع بداخل هذه السوق مع ما يتلاءم واحتياجات المجتمع. وحيث إن هذا القطاع هو المستوعب الرئيسى للفقراء فلابد من العمل على تنمية مهارات العاملين به وتوفير الحماية والضمان الاجتماعى لهم ويكون ذلك من خلال سياسات طويلة الأجل تهدف فى النهاية إلى تحويل هذا القطاع إلى القطاع الرسمى. وذلك عن طريق توفير الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية للعاملين بهذا القطاع.
سادساً: طبيعة النظام الاقتصادى
يشير الفصل الثانى من الدستور إلى المقومات الاقتصادية، وهنا يصبح التساؤل: «هل كان من المطلوب النص على طبيعة النظام الاقتصادى للدولة أم لا؟». فى الحقيقة أن الإجابة عن هذا التساؤل تتطلب التفرقة بين الدساتير فى الدول الشمولية ومثيلتها فى الدول الديمقراطية. فمن المعروف أن الدول الأولى تصر على وضع وتوضيح طبيعة النظام الاقتصادى فى ثنايا الدستور، وهو ما يضع بدوره حاجزاً على القوى والأفكار السياسية التى تتناقض مع هذه التوجهات والسياسات، ويؤدى إلى حرمان جماعات كثيرة من حقها فى ممارسة العمل السياسى، فالنص على الاشتراكية مثلاً يستبعد بالضرورة التيارات الليبرالية من الحياة السياسية والعكس صحيح، إذ إن اختيار بديل تنموى معين لا يعد عملاً فنياً محايداً على الإطلاق، وذلك لأن كل بديل ينطلق من رؤية معينة ومصالح محددة ويترتب عليه نتائج مختلفة لفئات المجتمع، بل إن اختيار بديل معين قد يترتب عليه اتخاذ مواقف معينة تجاه قوى أو دول أخرى. من هنا تأتى أهمية الحوار المجتمعى للوصول إلى أفضل البدائل التنموية المتاحة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة فى لحظة زمنية معينة.
وبالتالى كان من الأوفق عدم النص على طبيعة النظام الاقتصادى فى الدستور بحيث تترك مفتوحة لاجتهادات التيارات السياسية فى معترك الحياة العملية والاكتفاء فقط بوضع الأطر المنظمة للنشاط الاقتصادى فى المجتمع، مع التأكيد على ضمان الدولة توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بالجودة والأسعار المناسبة.
لكل ما سبق فنحن نتفق مع ما ذهب إليه الدستور من عدم تحديد لطبيعة النظام الاقتصادى والاكتفاء بتحديد الهدف منه، فأشارت المادة 27 إلى الهدف من النشاط الاقتصادى وهو «العمل على تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع مستويات المعيشة وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر»، وهى أهداف لا غبار عليها. وكنا نتمنى أن يتوقف النص عند هذه المسائل، لأن ما جاء بعد ذلك يتعلق بأدوات السياسة الاقتصادية وهى مسألة متغيرة حسب طبيعة التطور الاقتصادى والاجتماعى فى البلاد والأهداف التنموية المطروحة. فمثلاً الحديث عن ضرورة تشجيع التصدير - ورغم اتفاقنا الكامل مع أهمية الصادرات فى الاقتصاد القومى - إلا أن هذه المسألة تتعلق بطبيعة الأوضاع الاقتصادية للدولة فى مرحلة النمو، فأحياناً يكون من الأفضل اتباع سياسة الإحلال محل الواردات وليس تشجيع الصادرات، لذا من الأفضل أن تترك هذه الأمور لصانعى السياسات فى المجتمع وفقاً للأهداف التنموية المطروحة فى المرحلة التاريخية محل الدراسة.
وكذلك الحديث عن الاتزان المالى والتجارى، ورغم عدم اتفاقنا مع العبارة، إذ إنه كان من الأسلم الحديث عن التوازن المالى والميزان التجارى وليس التوازن التجارى، إذ إنها عبارة غير علمية، ولكن الأهم من ذلك أن مسألة التوازن المالى ترتبط بأوضاع الدولة، إذ إن تحديد خطورة العجز من عدمه ترتبط بالأساس بالحالة الاقتصادية للبلاد، فإذا كانت الدولة فى حالة كساد فإن السعى نحو تحقيق التوازن المحاسبى فى الموازنة يعتبر هدفاً غير سليم من المنظور المجتمعى، بل وقد يسهم فى المزيد من التباطؤ الاقتصادى. فالعبرة ليست بالتوازن الحسابى للموازنة وإنما بالتوازن المالى عبر الدورة الاقتصادية. فالتوازن المحاسبى ليس مقدساً أو مهماً فى ظل التوازن المالى على المدى البعيد.
وهذا لا ينفى بالطبع ضرورة العمل على علاج عجز الموازنة، ولكنه يتطلب أن يتم ذلك فى إطار تنموى ومن منظور شامل وواسع يأخذ بعين الاعتبار علاج الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد القومى ويدفع عجلة التنمية إلى الأمام، وبالتالى ينبغى أن توجه سياسات الإصلاح المالى إلى تحقيق هدف النمو الاقتصادى على الأجل الطويل. وذلك عن طريق رفع كفاءة الاستخدام للموارد المتاحة وتنميتها.. كما أن علاج عجز الموازنة لا يعنى إنهاء العجز بل يشير ببساطة إلى المستوى الذى يصبح عنده الاقتصاد قادراً على النمو دون مشكلات تضخمية أو ركود، وهو مستوى يجب البحث عنه بدقة وعناية فى ضوء الخبرة التاريخية للاقتصاد القومى وكذلك الأوضاع الاجتماعية الراهنة. ومن هنا يتمثل التحدى الذى يواجه الإنفاق العام فى ضمان مستوى من الإنفاق يتسق مع الاستقرار الاقتصادى الكلى ثم يتم بعد ذلك هيكلة الإنفاق كجزء من الإصلاح الشامل.
خاتمة
كما قال «روسو»: «عمّروا الأرض بالسكان على قدم المساواة وانشروا فى كل مكان حقوق الإنسان واحملوا إلى سائر أرجاء العالم الرخاء والحياة فبهذا تصبح الدولة من أقوى الدول وأصلحها حكماً بقدر المستطاع».
عن الوطن المصرية