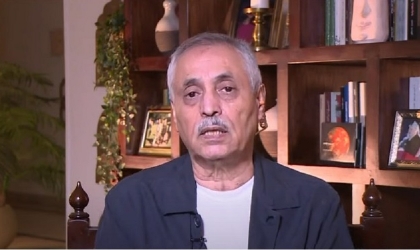لغة الديكتاتورية المحجبة

د. محمود عبد المجيد عساف
ساد عبر التاريخ فكرة مفادها أن الحرية بأنماطها هي الأساس، وأن القيود عليها هي الاستثناء، وما القانون والتشريع إلا تنظيم للحرية داخل المجتمع بما يضمن علاقة الأفراد ببعضها وعلاقة الأفراد بالدولة (السلطة)، بما يحقق القيمة المعنوية والنفسية لدور الفرد في تغيير المجتمع.
لكن الحقيقة التي بدأت تجوب أروقة السلطة، بمفهومها التسلطي، لا بمفهومها الذي ارتضاه المجتمع وشرعه، هي الاستقواء والتنمر العمدي على قضايا الانتهاك، والارتفاع بها إلى أبراج فكرية عالية بشكل مقصود هادف إلى الابتعاد بالحرية بعيداً عن مجال الواقع الاجتماعي بكل مكوناته (الصراعية-التنافسية- التوازنية)، كمحاولة لطمس الدور الفردي في التغيير، والتنوير والتحرر.
فنجحت السياقات الجديدة في تحويل الجدال حول الحرية إلى تعميمات وتهويمات وصراعات حول ما هو واجب وما هو محظور، وامتاز الخطاب السياسي والثقافي بتعويم قضية الحق لصالح فئات خاصة منتفعة، لتدخل البرلمانات والمؤسسات السياسية والأحزاب والمجتمع المدني في موافقة ضمنية غير مستشعرة على حكم الرجل الواحد، والرضوخ للقرار الواحد إلى الحد الذي قد نتنازل فيه عن حرياتنا مقابل حفنة مصالح مع صاحب النفوذ.
ليس الأمر بالتعميم بقدر ما هو تسليط الضوء على ظاهرة غريبة، تتمثل في التناقض بين الخطاب والمردود، حيث أصبحت المفاهيم المتصارعة باسم خطاب الحرية والديمقراطية وقبول التعددية، وحقوق الإنسان تمثل غطاءاً يخفي خطاباً سرياً (محجباً) تسلطياً يميل نحو الإجماع والتكتل المتمركز حول المصلحة، ونفي الآخر والتحفيز من شأنه، وإقصاء كل من تظهر عليه ملامح الحرية.
هذه الأنانية أفضت إلى تواطؤ جماعي فرضته أنساق القيم والثقافة التقليدية المعتمدة على مضمون (المصلحة الضيقة) على حساب المصلحة العامة، وحجمت الطلاقة الفكرية، والتوسع في مدركات العائد من الخير الجماعي برفض الرجل الواحد او القرار الواحد.
وعليه، فإن غياب الحرية الفردية وقولبتها في إطار المصلحة الشخصية الضيقة أدى إلى نقص عميق في الحيوية الاجتماعية والسياسية، ومن ثم أصبح الفرد ككيان مستقل(عقل- إمكانيات) غائب فعلياً في ساحة تقرير المصير، وأصبح تابعاً لمرجعيات تتحكم في مصيره ورؤيته المستقبلية.
ومن هذا المنطلق يمكن تفسير سطوة القلة السياسية أو الحزبية على جهود الأحرار، وتحكمها بمصائر قوى وجماعات، كان من الأصل أن يكون لها قوة التأثير على مجريات الأحداث، فتبرز إشكالية شرعية أو شرعنة التمثيل سياسياً واجتماعياً، وحتى ثقافياً، إذ تحولت حركة التمثيل على هذه المستويات أداة لتقنين المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية للصفوة الحاكمة بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم يعد من المفيد وجود القانون والعدالة، فالمرجعيات الممثلة تقود المسيرة، وتعرف ما لا نعرف.
إنها استراتيجية التغييب، وأزمة العقل التي جعلت منا إمعات، نكره التفكير في التغيير، ونستحسن بالعبودية على حساب مقاومة لغة الدكتاتورية المحجبة.
إن الحرية الفردية كمفهوم فلسفي وقانوني واجتماعي وثقافي وسياسي، يجب أن تمثل ملكة الخيال السياسي الواعي، غير المصنوع من قبل الأحزاب والمصدّر لنا على شكل أيديولوجيات ناصحة، وما هي إلا نخبوية تبحث عن ذواتها، تمارس القوة الناعمة لتستمر في صفقاتها، فغياب الحرية الفردية سيؤدي أو أدى فعلاً إلى انطلاق الغرائز التشريعية والأمنية والاقتصادية التي تغتال الحريات المدنية، ومصالح الأغلبية، لصالح شهوات الصفوة التي تدعي الخيرية.
إنها أزمة العقل يا سادة، العقل الذي ضاقت على خلاياه قنوات التفكير نحو الأفضل بحجة (لا بديل)، إنها أزمة تسليم الهوية الذاتية لغير أصحابها، فلم يعد العقل ناقداً للأحداث، وأصبح أسيراً لتحقيق الحد الأدنى من حاجاته، ولم تعد الهوية الفردية معبرة عن ذاتها بقدر ما تبحث عن انتمائها، لتكمل بهذا الانتماء ما يعتريها من احتياج، وهذا هو الفرق ما بين الولاء لوطن، والولاء لمصلحة.