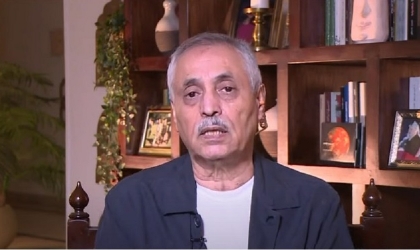هل كان صدام حسين على حق؟

ياسر عبد العزيز
قبل أيام كتب الدكتور حسام بدراوى، على «تويتر»، ما يلى: «لم أقابل (صدام)، ولكنى تأثرت سلباً بمن هربوا من جبروته فى العراق، وبنيت رأياً ليس محايداً ضده.
وأوازن اليوم بين العراق وهو رئيسه كقوة إقليمية وبلد ينمو اقتصادياً وتعليمياً، ويمتلك بنية بشرية محترمة، وبين العراق بعد غزوه، وما حدث له، وأتعجب على حكم التاريخ.. له أم عليه؟».
يلخص هذا السؤال الجوهرى عن حكم التاريخ على صدام، وأمثاله، معضلة تشغل الفكر السياسى راهناً، وهى المعضلة التى تبحث فى ما إذا كان معيار الحكم الصالح والجيد يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، أم يتصل بالأمن والاستقرار والإنجاز.
لا يوجد عاقل يمكن أن يدحض الطرح الذى يقول إن حكماً ديمقراطياً صالحاً قادراً على الإنجاز وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، واحترام حقوق الإنسان فى آن، يبقى أفضل وأعز ما يحصل عليه شعب أو تدركه دولة.
لكن الإشكال يكمن فى أنه أحياناً ما تجد بعض الشعوب نفسها مضطرة إلى الاختيار بين نمطين من الحكم، أحدهما ديمقراطى تعددى منفتح لا يتغول على حقوق الإنسان، ولا يقوى على تحقيق الاستقرار والإنجاز، والآخر ديكتاتورى مستبد يقهرهم ويكبت حريتهم، لكنه يلبى استحقاقات الدولة، ويحرز تقدماً مطرداً قابلاً للقياس.
قبل يومين، قال باتريك بوكانان، السياسى الأمريكى اليمينى، الذى عمل مستشاراً رفيعاً فى إدارات نيكسون وفورد وريجان، إن «الديمقراطية فقدت فعاليتها لإقامة دولة قوية مزدهرة، وإن نوع النظام السياسى لم يعد عاملاً من عوامل التنمية»، وإن «نمط الديمقراطية السائد فى الولايات المتحدة جعل منها بلداً غير جاد يضيع وقته فى التفاهات».
لقد ضرب «بوكانان» مثلاً بكل من روسيا والصين، قائلاً إن البلدين «نهضا من الرماد، ويعززان قوتهما، ويحققان الازدهار» من دون السير على خريطة الديمقراطية الغربية، ومن دون الاكتراث بمبادئ الحرية وحقوق الإنسان، التى يمكن أن تقود إلى «فناء العنصر الغربى لمصلحة السيل الجارف من المهاجرين الذين يتدفقون على وقع أنغام الأحاديث عن التنوع والتعدد والمساواة».
لماذا تحتل الصين تلك المكانة الدولية المميزة؟ وتنافس أعتى دول العالم اقتصادياً؟ ولماذا تحقق تقدماً مطرداً فى معدلات التنمية البشرية؟
لم تكن الديمقراطية هى السبب فى تحقيق تلك النتائج، بل إن الديمقراطية لم تنجح فى تحقيق مثل تلك النتائج فى باكستان أو حتى فى الهند، وها هى تشهد هجمات مرتدة خطيرة فى أهم معاقلها.
وفى المقابل، تبرز المخاوف فى الولايات المتحدة إزاء احتمال أن ينجح ترامب فى تخطى العقبات التى تواجهه، ليكرس نمط حكم يمينياً متطرفاً، يأخذ بلاده، والغرب، ومناطق أخرى من العالم إلى مستقبل مجهول، يتحكم فيه اليمين المتطرف فى عواصم القرار المؤثرة، وتتبدل منظومة القيم السياسية العالمية المعتبرة، وتحل مكانها منظومة جديدة تغذى نزعات اليمين المتطرف، وتعيد العالم الغربى إلى أزمان غابرة.
كان «بوكانان» نفسه قد نشر كتاباً مثيراً للاهتمام قبل سنوات بعنوان «موت الغرب» The Death of the West، وهو الكتاب الذى حذر فيه من «قنبلة ديموجرافية» تتمثل فى ملايين المهاجرين من الشبان، الذين يصلون إلى دول العالم الغربى العجوز، ويعيشون فيها، ويتمتعون بمزاياها الاقتصادية والديمقراطية، ثم يغيرون هويتها وثقافتها، ويستأثرون بما تمنحه من فرص.
تلك هجمة إذن تستهدف نمط الديمقراطية وحقوق الإنسان فى الغرب، وتمتدح طرق الحكم السائدة فى بلدان غير ديمقراطية، لطالما كانت هدفاً لانتقادات الأمريكيين والأوروبيين، لأن قادة فى دول مثل الصين وروسيا وماليزيا وسنغافورة نجحوا فى تحقيق أهدافهم بطريقة مختلفة عن تلك التى يؤمن بها الغربيون ويتمسكون بها.
والواقع أن الصين حققت تلك النتائج لأن نظام الحكم بها استطاع أن يحافظ على استقرار البلاد وسلامتها الإقليمية، ومنحها القدر الواجب من الشعور بالمكانة والفخر الوطنى، وأخرج 400 مليون مواطن من الفقر إلى الكفاية، فحظى بالقبول والرضا، وامتلك شرعية الإنجاز، من خلال قواعد تنافسية مرنة داخل الإطار السياسى الواحد.
استطاعت الصين تحقيق ذلك عبر «الحوكمة»، التى يُعرّفها البعض بأنها «خليط من السلام والنظام والحكم الرشيد، عبر ممارسة حركية لسياسة الإدارة العامة وطاقتها. ورغم أنها لا تقنن منح السلطة أو تنازعها فى أحيان عديدة، فإنها تُلزم الحكم بقرارات ناجعة تصادف التوقعات، وتحتم التحقق من الأداء».
روسيا أيضاً تغيرت، فى ظل حكم الرجل القوى بوتين، الذى يصفه الغرب بأنه عدو الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن غالبية الروس يضعون ثقتهم فيه، وسياساته تحقق المزيد من النجاح لبلاده، وتستعيد مركزها الدولى بثقة واقتدار.
هل تعنى «الحوكمة» إذن إقامة نظام استبدادى، وانتهاك حقوق الإنسان، وممارسة الطغيان، وإعلان الديكتاتورية؟
لا.. على العكس تماماً. «الحوكمة» تتطلب استقرار النظام، وهو أمر لا يتم من دون القبول والرضا، وهذان العنصران لا يتحققان فى ظل الاستبداد والطغيان، بل يتحققان من خلال الإنجاز، وإخضاع الأداء للتقييم، ومحاربة الفساد، وحماية المصالح العليا، وصيانة الأمن القومى، وتحقيق التوقعات.
لقد فشل صدام فى تحقيق أهدافه، رغم نجاحاته فى البدايات، لأنه ببساطة لم يعتنق أياً من النمطين: الديمقراطية والحوكمة. ولم يهيئ لنظامه مساراً مرناً للتطور والانتقال.
ولذلك، فقد ظل ما حققه عرضة للانهيار، وختاماً، فقد أسلم بلاده للتمزق.
لم تنتهِ حكاية الصين وروسيا، وغيرهما من بلدان العالم، فى الخليج، وأمريكا اللاتينية، وشرق آسيا، وهى بلدان بنى بعضها تقدماً مطرداً من دون ديمقراطية وحقوق إنسان، وعلينا أن نراقب ما إذا كانت ستدرك اللحظة المناسبة التى تحول فيها نظم الحكم إلى أنساق أكثر مرونة وقابلية لاحترام التعدد والتنافس ومصالح الأطراف، أم أنها ستضيع إنجازاتها عندما تكرس حكماً مستبداً وجامداً، يقوده ديكتاتور يحكم وحده إلى الأبد، قبل أن يسلم الحكم لوريث من نسله أو من حزبه.
سيبقى الإشكال الأكبر متعلقاً بدول تخفق فى بناء نظم حكم ديمقراطية فعالة، كما تخفق فى تحقيق الإنجاز والحوكمة وتفعيل أسس الحكم الرشيد، وهى بلدان ستبقى برسم الضياع، تماماً مثلما حصل للعراق.
عن الوطن المصرية