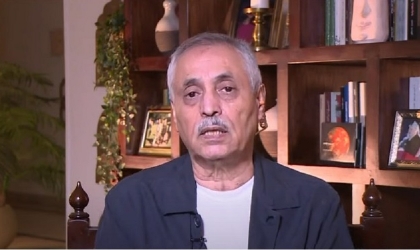سيرة وطن سيرة حياة - ح 3

(6)
الفكر السياسي الفلسطيني، إلى أين؟
بعد أحداث أيلول الدامية في الأردن جرى اعتقالي يوم 16/6/1971 في مخيم الوحدات في عمان، وصباح يوم 19/9/1973 غادرت معتقل الجفر الصحراوي، بعد اعتقال دام أكثر من 28 شهرا، مع من تبقى من المعتقلين الذين جرى اعتقالهم بعد أحداث أيلول الدامية. كنا ما يزيد على ألف معتقل، تكومنا في الباصات أو الحافلات، والتي زادت على العشرين. وانطلقت بنا الحافلات وأخذت تشق طريقها بنا مسرعة إلى آفاق الحرية، إلى الحياة. وهكذا أغلق معتقل الجفر الصحراوي أبوابه على قصص وحكايات، وذكريات وصور إنسانية، عن الصمود وعن العذاب والمعاناة.
الطريق الصحراوي من الجفر إلى عمان طويل. الصحراء تحف بنا من كل جانب كأنها بلا نهاية، الشارع الأسفلتي الطويل يمتد أمامنا طويلا كأفعوان يتلوى وكأنه بلا نهاية، أنظر في وجوه كل من حولي في الحافلة فأراها باتت تشرق بالحياة بالأمل. وبعد قليل من الوقت والأحاديث المتبادلة، ساد ما يشبه الصمت بيننا. فالجميع على ما يبدو أخذ يغفو بعد ليالٍ من السهد والترقب والقلق، وأنا أخذت عيوني يداعبها النعاس، ولكن ذهني ظل مستيقظا يستعيد ذكريات وأفكار عاشت معي خلال أيام سجني الطويلة.
لقد استيقظ وعيي منذ كنت طفلا مع نكبة فلسطين الأولى عام 1948 وما تلاها من أحداث وفواجع ألمت بنا كشعب. ونما وتطور ونضج هذا الوعي مع نكبة فلسطين الثانية في العام 1967، التي لم تكن أقل قسوة من النكبة الأولى، على الرغم مما أعقبها من أمل لم يدم طويلا. وما بين نكبة وأخرى كانت أفكاري ورؤيتي للأحداث تتطور، وأحيانا تتغير باتجاهات تتلاءم مع الوقائع والمتغيرات المستجدة.
أحداث أيلول الدامية عام 1970، لم تكن حدثا بسيطا في حياة الشعب الفلسطيني وحركة المقاومة الفلسطينية الناشئة. لقد كانت حدثا وجه ضربة قوية للحركة الفدائية إذ أفقدها القاعدة الأهم، التي تضم الجزء الأكبر من الشعب الفلسطيني خارج أرض الوطن، والتي كانت تنطلق منها إلى الداخل الفلسطيني. والتساؤل الذي شغل ذهني خلال وجودي في المعتقل هو: هل كان الصدام المبكر بين الحركة الفدائية وسلطة النظام الأردني حتميا، أم كان ممكنا تجنب هذا الصدام، أو على الأقل مد فترة التعايش أطول فترة ممكنة إلى حين يقوى ويتصلب عود الحركة الفدائية، بحيث تتبلور حالة من التكافؤ أو شبه التكافؤ في القوى بين الطرفين، تجعل من الصدام بينهما مكلفا لكلا الطرفين.
قد يرى البعض أن مثل هذا الاحتمال ليس ممكنا، باعتبار أن كلا الطرفين لا يمكن أن يتعايشا معا بحكم اختلاف وتناقض أهدافهما ومسارهما السياسي. بتقديري، أن هذا التقدير مبالغ فيه، إلى حد ما، وأن احتمالات التعايش فترة أطول، أو تجنب الصدام بالشكل المأساوي الذي حدث كان ممكنا، لو أحسنت الحركة الفدائية بكل أطرافها مسلكيتها العامة، ولم تفرض مبكرا سلطتها كسلطة موازية، وربما تفوق سلطة النظام، مما زاد من تأزيم النظام وتمكينه من حشد قوى لصالحه وتأليبها على الحركة الفدائية. بتقديري أن جزءا من المسؤولية تتحمله الحركة الفدائية، وبالأخص أطراف من يسار المقاومة الجديد، التي أججت بشعاراتها المتطرفة وممارساتها الفالتة من أية ضوابط، مثل خطف الطائرات وتوجيهها إلى مطار مستحدث في الأردن، وغيرها، شكلت بمجموعها عوامل زادت من اندفاع سلطة النظام نحو المواجهة والصدام، مدعوما برغبة قوى دولية، وعربية إلى حد ما. لقد وقفت ضد هذه الممارسات والسياسات الخاطئة، وحاربتها وانتقدتها في حدود إمكانياتي من موقعي القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
السجن، بالرغم من المعاناة التي يعيشها الإنسان في سجنه، ينشط الذاكرة ويبعث الذكريات قوية في ذهن الإنسان، وهي ذكريات يقتات عليها السجين وتعينه على الصمود. السجن بالنسبة لي، لم يكن فقط محطة للذاكرة والذكريات، وإنما كان بمثابة فسحة من الصفاء الذهني والعقلي للتأمل والتفكير، فيما مر بنا من أحداث، وما يمكن أن نواجهه في قادم الأيام.
أحداث أيلول الدامية ووفاة الرئيس جمال عبد الناصر التي أعقبتها بأيام قليلة، وقبل أن يُكمل مشروعه في إعادة بناء الجيش المصري لاستعادة الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة في حزيران 1967، شكلتا ضربة مضاعفة لحركة المقاومة الفلسطينية الناشئة. ذلك أن الرئيس جمال عبد الناصر، بالرغم من قبوله بمشروع روجرز "وزير الخارجية الأميركي" الذي رفضته حركة المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها وقادت حملة ضد الرئيس عبد الناصر لموافقته على المشروع الأميركي، ظل بمثابة الأمل بالنسبة للجماهير العربية ومحل ثقتها، وتحفظ له مواقفه الداعمة للمقاومة الفلسطينية، حتى وهي تشن حملة ضده، كما تحفظ له مواقفه القوية ضد العدوانية الإسرائيلية المتنامية، وشن حرب استنزاف ناجحة وفاعلة ضد القوات الإسرائيلية في سيناء. وما زاد الطين بلة، أن أنور السادات الذي خلف الرئيس عبد الناصر كرئيس لمصر "الجمهورية العربية المتحدة" آنذاك. لم يحز على الحد الأدنى من ثقة الجماهير العربية، وأفقدها الثقة بفعالية الجهد القومي العربي المقاوم ضد العدوانية الإسرائيلية وتحرير الأرض المغتصبة.
كنت خلال وجودي في المعتقل أتابع ما يصلنا من أخبار عن تحركات السادات ومحاولاته الدؤوبة للوصول إلى أتفاق جزئي مع إسرائيل لفتح قناة السويس، مقدمة لعقد صلح منفرد معها. وكنت ككثيرين غيري لا نثق بتلويحه المتواصل وتهديده إسرائيل بشن حرب ضدها.
لقد حاول أنور السادات أكثر من مره بعد سيطرته على الحكم في مصر، عقد اتفاق جزئي مع إسرائيل لفتح قناة السويس، ليكون بمثابة بداية لحل سياسي مع إسرائيل حول احتلالها لسيناء، إلا أن الحكومة الإسرائيلية بزعامة غولدا مائير وقياداتها العسكرية، الذين كانوا مأخوذين حتى الثمالة بما حققوه من انتصار سهل ومريح وغير مكلف في حرب حزيران، كانوا بكل غطرسة واستعلاء يرفضون حتى مجرد البحث في مثل هكذا مبادرات، ولديهم اعتقاد راسخ بأن الجيوش العربية التي انهزمت شر هزيمة في حرب حزيران، لن يجرؤ أي منها على شن حربا ضد إسرائيل.
كان السادات، الذي فشلت محاولاته ومبادراته لفتح مجرد حوار مع إسرائيل، قد أخذ في العام 1971 يعلن أن حربا لا بد منها مع إسرائيل، وتجرأ أواسط عام 1971 ليعلن أن عام 1971 هو عام الحسم، وإذا لم تتجاوب إسرائيل مع مبادراته سيشن الحرب عليها قبل نهاية العام.
كانت إسرائيل تتعامل مع إعلانات السادات عن الحرب وعام الحسم بالكثير من السخرية والهزء، وبخاصة أن العام 1971 مر دون أن يحدث أي شيء مما كان يعلنه السادات، والذي ادعى أنه لم يذهب إلى الحرب عام 1971 بسبب ما ادعاه من “ضباب" خيم على العالم باندلاع الحرب الهندية الباكستانية عام 1971، والتي أدت إلى انسلاخ باكستان الشرقية عن باكستان وقيام دولة بنغلادش.
في الحقيقة، تحول أنور السادات وادعاءاته بشن الحرب إلى أُضحوكة، وبخاصة بما أعلنه عن ضباب الحرب الباكستانية الهندية، ليس في نظر إسرائيل فقط، وإنما في نظر العالم وكل الشعوب العربية. وترسخ الانطباع لدى الجميع، أنه لا السادات أو غيره من الحكام العرب، لديه الجرأة أو الإمكانية لشن حرب ضد إسرائيل. ونامت إسرائيل على تقديرات أجهزة مخابراتها بأن لا حرب ممكنة أو محتملة، لا حاليا ولا في المستقبل، وأن هزيمة عام 1967 نخرت عميقا في جسد النظام العربي. وهذا ما طغى أيضا على الجميع، بمن فيهم القيادة الفلسطينية، التي أخذت تعيد بناء تشكيلاتها العسكرية وغيرها على الحدود اللبنانية المتاخمة لإسرائيل، في ضوء أن النظام السوري يُحكم قبضته على حدوده مع إسرائيل، لم يكن يسمح لأي كان من فصائل المقاومة القيام بنشاط عسكري في منطقة الجولان السورية المحتلة.
في ضوء كل تلك الأحداث والوقائع المستجدة بدأت أُدرك أن الخيار العسكري العربي لتحرير الأرض المحتلة عام 1967، بات بعيدا وربما لم يعد محتملا، وأن إعادة التفكير بما يجري واستخلاص العبر واشتقاق السياسات الواقعية لمواجهة ما يجري وما يستجد من أحداث، بات ضروريا.
لقد صعدت الوطنية الفلسطينية ونهضت في أوائل الستينيات مدفوعة بعجز النظام العربي عن التجسيد الحقيقي لما يرفعه من شعارات خادعة حول الإعداد لتحرير فلسطين، قامت أنظمة وسقطت أنظمة واحتل العسكر سدة الحكم بادعاء الإعداد لمعركة التحرير. تم قمع الشعوب العربية واضطهاد قواها الوطنية والتقدمية تحت يافطة التحرير، وامتلأت السجون والمعتقلات بالمناضلين من شيوعيين وتقدميين ووطنيين إعدادا للتحرير؟! وفي أول امتحان لهذه الأنظمة عند قيام إسرائيل بالشروع بتحويل مجرى نهر الأردن أواخر عام 1963 لإرواء النقب جنوب فلسطين، أرض المستقبل بالنسبة لإسرائيل، تكشف عجز النظام العربي عن الرد على ذلك. وتكشف بشكل فاضح في هزيمة حزيران عام 1967. والآن على الشعب الفلسطيني ممثلا بإطاره التنظيمي الجامع والقائد لحركة نضاله م.ت.ف، أن يستخلص العبر، ويعيد الإمساك بزمام قضيته، ويشتق السياسات والمواقف الواقعية، التي تحافظ على قضيته من الاندثار، أو عودتها لأشكال من الوصاية والإتباع، كما كان الأمر عليه قبل عام 1967.
(7)
بدايات تحول أولية في الفكر السياسي الفلسطيني
في شهر آب من كل عام يكون الجو شديد الحرارة، ويكون أقسى وأشد في المناخ الصحراوي، على الرغم من أنه ليلا يتجه نحو شيء من البرودة. جو متقلب في اليوم الواحد بين الحر الشديد والبرودة، كحال وضعنا ومصيرنا السياسي المتقلب باستمرار بين الأمل الشديد والخيبة.
كنا في معتقل الجفر الصحراوي نصحو عادة باكرا على حركة الغفير الذي يسلمنا مؤونة الخبز لليوم وفطور الصباح. بعضنا يمارس بعض التمارين الرياضية فور الاستيقاظ، للحفاظ على شيء من لياقته البدنية، ومنع الخمول من التسرب إلى عقله وذاكرته. بعد ذلك، نتناول في أغلب الأحيان فطورا جماعيا، يكون زاخرا بالمأكولات التي جلبها الزوار لأحبائهم من المعتقلين. ثم يتوزع الجميع، البعض يتجه إلى داخل البركس، يقرأ إذا توفر ما يقرأه، والبعض يلعب الورق أو الشطرنج، وبعض آخر يتمشى في باحة البركس، إما كأفراد يستعيدون خلال المشي بعضا من ذكرياتهم وأحوالهم الخاصة، أو كمجموعات صغيرة تتداول في بعض الأمور السياسية أو غيرها.
في يوم من أيام هذا الشهر الملتهب الحرارة عام 1972، كنت أتمشى لوحدي أستعيد بعض الأفكار التي شغلت ذهني حول وضعنا ومصير قضيتنا الوطنية بعد ما شهدناه من أحداث جسام خلال العامين الماضيين. لمحت وأنا أتمشى أحد الرفاق منزويا لوحده في إحدى زوايا باحة البركس، حانيا رأسه مسندا به على كف يده. تقدمت إليه، وباشرته بالسؤال:
ما بك يا رفيق هل هناك ما يزعجك؟
يبدو أنه تفاجأ باقتحامي خلوته. رفع رأسه ونظر إليَّ وقال بشيء من الحزن:
"لا شيء يا رفيق، ولكن منذ أيام لا أنام الليالي وأنا أفكر بمصيرنا، ليس كمعتقلين لأنه مهما طال اعتقالنا سنغادر هذا المعتقل البغيض، ما يقلقني ويؤرقني أن قضيتنا الوطنية باتت في مهب الريح، العرب لن يحاربوا على ما يبدو بعد وفاة الرئيس عبد الناصر، فالسادات بات أضحوكة الجميع بعد ادعاءاته الفارغة من أي مضمون عن الحرب، والمقاومة الفلسطينية تعاني من الحصار وتآلب الكثيرين عليها، من عرب وغيرهم، وإسرائيل تواصل قتل شعبنا والاستيلاء على أرضه وزرعها بالمستوطنين. بالَك يا رفيق في حل لقضيتنا، أم سنعود القهقرى إلى ما كنا عليه بعد نكبة العام 1948، مجرد لاجئين تلفظنا وتقسو علينا الأنظمة العربية، التي تاجرت بقضيتنا ومستقبل شعبنا."
كنت أصغي باهتمام شديد للرفيق وهو يتلو عليَّ ما يجول في ذهنه. وضعت يدي على كتفه وقلت له:
"ما بك يا رفيق، خلِّ ثقتك بنفسك وبشعبك قوية، فالصعاب أيا كانت لن تقهر إرادة الشعوب وهي تصمم وتكافح لانتزاع حريتها وحقها في الحياة وهذا مصير كل الشعوب التي نهضت للدفاع عن حريتها واستقلالها الوطني."
نظر إليَّ وشبه ابتسامة حزينة ارتسمت على محياه، وقال:
"أنا لم أفقد الثقة بشعبنا، ولكني أقول لك ما توصلت إليه بعد تفكير عميق، إن سلاحنا الأقوى في مواجهة هذا العدو المتغطرس، هو الحفاظ على شعبنا مقيما على أرضه الوطنية، وحيث يتواجد في المنافي والشتات، ضد محاولات إبادته كأننا من بقايا الهنود الحمر الذين أبادهم المستعمر الإنجليزي-الأميركي، أنا على يقين أن شعبنا حي وبات متمرسا على النضال، وإرادته في مواصلة النضال قوية وعالية مهما علت التضحيات. ومن أجل أن نبقى عصيين على الإبادة، يجب على شعبنا أن يكثر من النسل."
توقف قليلا ثم تابع حديثه وعلى شفتيه شبه ابتسامة: "يا أخي ليتزوج الواحد منا بدل الواحدة ليتزوج أربعة، (ابتسمت وهو يتحدث عن الزواج بأربع نساء) ويخلف منهن النسل الكثير، وذلك حتى نبقى شوكة كبيرة في حلوقهم، عصية على البلع، مهما قتَّلوا أو أبادوا منا. إسرائيل، بالرغم مما تلقاه من دعم دولي، وعربي مُبطن، لم يكن بإمكانها الصمود والبقاء على أرضنا، لولا السيل المتواصل من اليهود الذين تدفقوا عليها من مختلف بقاع الأرض، وللأسف كانوا، في معظمهم، من يهود البلدان العربية، حين سهلت، أو تواطأت، الدول العربية على هجرة اليهود المقيمين على أراضيها من قرون إلى إسرائيل. هذا هو الحل ي نظري، إلى أن يقتنع العالم الذي دعم إقامة هذا الكيان العدواني الاستيطاني، على أرضنا وأمده بكل أسباب القوة، أننا شعب يستحق الحياة، ويستحق أن يكون له كيانه الوطني الحر والمستقل على أرضه الوطنية، التي عاش وأقام عليها منذ آلاف السنين، أسوة بباقي شعوب الأرض".
في المساء عندما دلفنا إلى مهاجعنا وأغلق الغفير باب البركس بعد أن قام بالعد اليومي المعتاد للموجودين، جلست على برشي وأخذت أُمعن فكري فيما قاله الرفيق، وأخذ ت أتساءل بيني وبين نفسي كحالة من العصف الفكري في ذهني، فيما قاله الرفيق عن أهمية البقاء والصمود على أرض الوطن لشعبنا ولو على جزء منه، وأتساءل فيما إذا كانت قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية قبل العام 1948 قد أخطأت سياسيا حين أحجمت، وبشكل مطلق، عن التعاطي بشيء من المرونة والمناورة السياسية، أو حتى الاستكشافية لما كان يُطرح من مشاريع وأفكار تتعلق بموضوع القضية الفلسطينية، منذ أن أُبتُليَ الشعب الفلسطيني بالغزو الاستعماري البريطاني وبالغزو الاستيطاني الصهيوني. لماذا انتهجت سياسيا وبشكل دائم، خط الرفض المطلق لكل شيء، غير عابئة بما كان يجري حولها وبما يُستجد من وقائع كانت تنذر بالكثير من المخاطر المحدقة بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية. هل سياسة الرفض المطلق كانت مجدية بالنتيجة، أم أنها كانت من العوامل الأساسية التي أدت إلى النكبة القاسية عام 1948.
وتساؤل يتبعه تساؤلات أخرى كثيرة، لعل من أهمها، ماذا عن سياسات ومواقف مواصلة التمسك والتمترس وراء الهدف المركزي بالتحرير الشامل، والإحجام عن الاتعاظ بتجربة الحركة الوطنية الفلسطينية قبل العام 1948، التي انتهجت سياسات رفضاوية متشددة تفتقر إلى الحد الأدنى من المرونة السياسية، وشكلت أحد أهم أسباب فشلها. هل الانطلاقة القوية للحركة الفدائية في مرحلتها الجديدة والآمال المبالغ فيها التي بعثتها في نفوسنا، حجبت عنا رؤية الواقع الجديد بكل أبعاده وتفاصيله، ما جعلنا نواصل النهج نفسه "يا فلسطين كلها يا بلاها" وفقا لما دأب الكاتب الفلسطيني فيصل الحوراني يردده في بعض كتاباته لاحقا على سبيل النكتة، تعبيرا عن سياسة الرفض المطلق الذي اتسمت بها الحركة الوطنية منذ بداياتها. هل من خطأ لو انتهجت القيادة الفلسطينية خطا سياسيا وبرنامجا نضاليا يستند إلى ما أقرته الأمم المتحدة بموجب قرار التقسيم عام 1947، بدلا من مواصلة التمترس وراء استراتيجية التحرير الكامل، بدون اللجوء إلى برامج عمل تتسم بالمرونة السياسية وبالتعاطي المرحلي للهدف الفلسطيني، وفقا لتطور الظروف والأوضاع، وهل قيادات الشعب الفلسطيني، كما يُقال عنها، "ما أسهل أن نُضَيع الفرص حتى تعود وتركض وراءها بعد أن تكون قد أفلتت الفرصة وفات أوان إمكانية تنفيذها.". أو ليس صحيحا ما يقال قوة أي قرار في التوقيت الصحيح لاتخاذه. ذلك أن "القرار الصح في الوقت الصح قوة" و"القرار الصح في غير وقته ضعف".
أسئلة كهذه راودت ذهني في وقت مبكر، إلى حد ما، ولكن لم أكن أجد في نفسي الجرأة للبوح بها. حتى الشيوعيون الفلسطينيون الذين قبلوا بمشروع التقسيم عام 1947، لم يجرؤوا على طرح موقف جدي يتعارض مع موقف القيادة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بل عملوا على التكيف مع الموقف الرسمي الفلسطيني لضمان قبولهم في عضوية منظمة التحرير الفلسطينية كتنظيم أو فصيل مستقل.
أستطيع القول عن نفسي بكل صدق، أنني عمليا كنت منساقا مع الاتجاه الرسمي لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي كنت أنتمي لها، على الرغم مما كان يعتمل في ذهني من أفكار، أحاول أن أجد لها طريقا للتعبير عنها. وأذكر أنه من وحي هذه التساؤلات "الخفية" أخضعت للنقاش مع عدد من الرفاق في المعتقل، تجربة الزعيم الاشتراكي سلفادور أليندي في التشيلي الذي نجح في 3/11/1971 في خوض أول تجربة ديمقراطية للوصول إلى بناء مجتمع اشتراكي في التشيلي بالوسائل الديمقراطية وبأحزاب متعددة وبانتقال سلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع وليس عبر العنف المسلح. وبالرغم من أن تجربة "سلفادور اليندي" لم تدم طويلا، حيث أجهزت عليها القوى الرجعية بزعامة الجنرال العسكري "بينوشيت" وبدعم من الامبريالية الأميركية في 11/9/1973، إلا أنها أثارت في ذهني الكثير من التساؤلات حول آلية الوصول لتحقيق الأهداف عبر أكثر من وسيلة نضالية وفقا للظروف ومكونات الواقع.
أذكر أنه بعد أحداث أيلول الدامية في الأردن بأشهر قليلة بدأت تتردد في بعض الأوساط القيادية الفلسطينية معلومات غامضة وغير دقيقة وأشبه بالإشاعات، عن تحرك أميركي غير رسمي عبر أكاديميين وصحفيين، قاموا بالاتصال ببعض المثقفين الفلسطينيين في داخل فلسطين وخارجها لتمرير فكرة عن قيام كيان فلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بدعم من الولايات المتحدة. وتردد في حينها أن الإدارة الأميركية كانت تخشى أن تلجأ الحركة الفدائية بعد الضربة التي تلقتها في الأردن، إلى العمل السري المسلح وتهدد بعملياتها المسلحة مواقع النفط في الخليج العربي والسعودية.
وقد كشف عن ذلك لاحقا الكاتب الإسرائيلي بنحاس عنبري في كتابه "الاتصالات السرية بين الولايات المتحدة والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية"، واطلعت على تلخيص لما ورد في الكتاب حول هذا الموضوع لاحقا، في مقال في جريدة "القدس العربي" الصادرة في لندن بتاريخ 26/8/1999، نشره الكاتب الفلسطيني حمدان بدر، والذي كان يعمل في مركز الأبحاث الفلسطيني في بيروت، ويقول حمدان في تلخيصه المذكور نقلا عن الكاتب عنبري "إن واضعي السياسة الأميركية أدركوا أنه ليس بالإمكان تصفية منظمة التحرير الفلسطينية، ومن جهة أخرى فإن إغلاق الطريق أمامها، يمكن أن يدفعها إلى أن تصبح منظمة إرهابية من أشخاص يائسين... وإن أفرادها بدلا من التوجه إلى فلسطين سيتوجهون إلى أهداف في الشرق الأوسط، وخاصة المنشآت النفطية في الخليج العربي...وبناء على ذلك فقد أُلقيت على فيشر (بروفيسور أميركي اسمه روجرز فيشر من جامعة هارفارد) مهمة دعم التيار الذي نادى بالعمل السياسي العلني داخل المنظمة، ومنع المنظمة الفلسطينية من الانزلاق لتصبح منظمة عسكرية سرية تخرب المنشآت النفطية. وكانت المهمة التي طلب من فيشر ترويجها، هي السعي لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل."
أذكر أنه في تلك الفترة "أوائل العام 1971" وصلت إليَّ "طراطيش" عما كان يشاع في حينه حول هذا الموضوع، وكتبت مقالا حول الموضوع في جريدة "فتح" التي كانت بإشراف الإعلام الموحد ورئيس تحريرها الأخ ماجد أبو شرار، شككت بجدية ومصداقية ما يشاع عن توجه أميركي لإقامة كيان فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن الهدف الأميركي لما يُروج يستهدف النيل من الكفاح الفلسطيني المسلح ومن وحدة شعبنا النضالية. وأذكر انه لما طرح موضوع الكيان الفلسطيني "المسخ" في اجتماع اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 5/11/1970، تم رفض الفكرة جملة وتفصيلا بالإجماع، حتى تم رفض أي مناقشة لها. ومن وحي هذا الموقف كتب الرفيق غسان كنفاني في مجلة "الهدف" وهي المجلة الناطقة باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ويرأس تحريرها كنفاني نفسه، مقالا مطولا عن "دولة البانتستونات"، وهو مصطلح مستوحى من المنعزلات التي كان يقيمها حكام جنوب إفريقيا البيض للسكان السود لعزلهم عن السكان البيض، في إطار سياسة العزل والتمييز العنصري التي كانوا يمارسونها ضد السكان السود.
كانت تلك المرة الأولى التي ترد فيها فكرة إقامة كيان فلسطيني أو دولة فلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وقد رفضت الفكرة جملة وتفصيلا من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ومن جميع الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية على مختلف اتجاهاتها، وسماها الكل "الدولة المسخ" الخيانية، باعتبار كل من يوافق عليها خائن. وكان الأخ ياسر عرفات "أبو عمار" من أشد المتحمسين لرفضها، وبخاصة لما ورده من معلومات حول اتصالات يجريها أميركيون مع شخصيات في الأرض المحتلة، حيث اعتبر هذه الاتصالات بمثابة التفاف على منظمة التحرير الفلسطينية، القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني. ومن المفارقات التي لا بد من ذكرها أن النظام الأردني لم يكن مرتاحا لهذه الاتصالات ولفكرة قيام دولة فلسطينية، لأن الملك الأردني كان يأمل بإمكانية عقد اتفاق منفرد مع إسرائيل يستعيد بموجبه الضفة الغربية ويعيد ضمها إلى الأردن.
أما على الصعيد الفلسطيني، فقد كانت تجري بعد أحداث أيلول الدامية تساؤلات بين بعض الأوساط القيادية الفلسطينية حول مصير الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مثل هل مواصلة التمسك بشعار وحدة الضفتين في إطار المملكة الأردنية الهاشمية يخدم حركة النضال الفلسطيني، في ظل محاولات النظام الأردني المتواصلة للبحث منفردا وعبره، عن حل سياسي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، يبقيها تحت سيطرته. وتزايدت حدة هذه التساؤلات مع إعلان الملك الأردني مشروعا إلحاقيا جديدا للضفة الغربية في شهر آذار عام 1972 تحت مسمى "المملكة العربية المتحدة" وأخذ يروج لمشروعه في اتصالاته الدولية والعربية. منظمة التحرير الفلسطينية أعلنت رفضها لمشروع الملك الأردني، وتداعت قيادات فلسطينية للتداول في الوضع السياسي وتشكلت لجنة برئاسة الأخ صلاح خلف (أبو إياد) وبمشاركة قيادات من فتح والجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية وغيرها، وعقدت اجتماعا في شهر آذار 1972 تداولت خلاله مخاطر مشروع الملك الأردني على مصير ومستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة) والبحث عن بدائل لمواجهة المشروع الأردني.
بالرغم من أن الاجتماع لم يتوصل إلى نتائج محددة، إلا ان ما تم طرحه من أفكار أولية، وإن كانت مختلفة، فتح المجال لبحث أوسع وأشمل في الحوارات القيادية الداخلية لبعض الفصائل، وبخاصة في الجبهة الديمقراطية، للبحث عن توجه سياسي استراتيجي لحركة النضال الوطني الفلسطيني، يمكنها من مواجهة تطورات الأحداث، ويبقي موضوع مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، شأنا فلسطينيا بالأساس.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كانت أول من بادر إلى البحث عن خط سياسي جديد وجرت مناقشة بعض الأفكار الأولية حول هذا الموضوع، في اجتماع للجنتها المركزية عقدته في شهر آب عام 1973، ناقشت فيه العديد من الأفكار والتوجهات السياسية، وأقرت توجهات عامة حول برنامج كفاحي فلسطيني للخلاص الوطني من الاحتلال الاسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره. وهو البرنامج الذي أقرته لاحقا بعد حرب أكتوبر وتوافقت عليه مع قيادة حركة فتح حول قيام سلطة وطنية فلسطينية على أي جزء يتم تحريره من الأرض الفلسطينية، لتكون بمثابة قاعدة ارتكاز للنضال الوطني الفلسطيني، وبما يقطع الطريق على محاولات النظام لتجديد سياساته الإلحاقية للأرض الفلسطينية، ونشرت مجلة "الحرية" الناطقة بلسان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أفكارا أولية حول هذا البرنامج على عدة حلقات (سبع حلقات) باسم "يساري فلسطيني" قبل حرب أكتوبر بفترة قصيرة (من 27/8/ 1973 إلى 8/10/) 1973) واتضح لاحقا أن اليساري الفلسطيني غير المعلن هو الرفيق قيس السامرائي (أبو ليلى) عضو المكتب السياسي. ولم تفصح الجبهة الديمقراطية عن موقفها علنا إلا بعد حرب تشرين، عندما ظهر ما يبدو وكأن قطار التسوية السياسية بين العرب وإسرائيل أخذ يشق طريقه، ولا بد أن يكون موضوع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967على الطاولة، وبالتالي هل يعود النظام الأردني لضمها مجددا أم يتم إقامة سلطة وطنية فلسطينية عليها بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
خلال الأسابيع الأخيرة من وجودي في معتقل الجفر، وردتني رسالة من الرفاق في لبنان، تضمنت معلومات أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ناقشت في أحد اجتماعات لجنتها المركزية أفكارا أولية حول الفكرة الكيانية الفلسطينية أو الدولة الفلسطينية على جزء من الأرض الفلسطينية، وبلورت أفكارا أولية بهذا الخصوص، وأوعزت إلى عضو مكتبها السياسي الرفيق أبو ليلى بالتمهيد تلميحا لهذا الموقف عبر مقالات يكتبها في مجلة "الحرية"، ولما راجعت في المعتقل الرفيق صالح رأفت، القيادي في الجبهة الديمقراطية والذي كان يمثلها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قبل اعتقاله، بهذه المعلومات، أنكر الأمر وأكد أن الجبهة على موقفها كباقي الفصائل الأخرى ولكن تبين لي لاحقا، أن الرفيق إما أنه غائب عن الموضوع ولا يعلم، أو كان يخفيه لأمر ما.
هذا التوجه المبكر وغير المعلن رسميا للجبهة الديمقراطية، مكنها من القيام بدور مبادر، ريادي وعلني، في الحشد والتعبئة الجماهيرية لهذا الموقف، بعد حرب تشرين/أكتوبر، والذي تبلور بشكل نهائي ورسمي، بعد ان تبنته حركة فتح كبرى منظمات المقاومة الفلسطينية في البرنامج السياسي المرحلي "برنامج النقاط العشر" بدورة المجلس الوطني الفلسطيني الثانية عشرة المنعقدة في القاهرة في أوائل شهر حزيران عام 1974.
إضافة لذلك كان ثمة طرح مبكر لدولة فلسطين ديمقراطية على كامل أرض فلسطين التاريخية، يتعايش في إطارها كل مواطنيها من مسلمين ويهود ومسيحيين، طرحها القيادي في فتح، الأخ صلاح خلف أواخر العام 1969 أثناء انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة، طرحها كفكرة، دون أن يرفقها بأي توضيحات حول بنية هذ الدولة ومصير اليهود الحاليين المقيمين فيها. لكن هذه الفكرة سرعان ما تلاشت بعد أن رفضتها معظم فصائل المقاومة، وتحديدا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والفصائل المنتمية للاتجاه القومي كمنظمة طلائع حرب التحرير الشعبية¬-قوات الصاعقة، وجبهة التحرير العربية.
ولكن بالرغم من تجاهل معظم فصائل المقاومة للفكرة بمن فيهم مطلقها الأخ صلاح خلف، واصل بعض المثقفين الفلسطينيين في تناولها في بعض كتاباتهم. وأذكر أنى عندما كنت أعمل في مركز الأبحاث الفلسطيني في بيروت بعد خروجي من المعتقل، قدمت مشروعا لإعداد كتاب مفصل عن الموضوع، فكثفت من قراءاتي حول الموضوع، ولفت نظري كتاب حول "الدولة ثنائية القومية في عهد الانتداب البريطاني" باللغة الانجليزية للكاتبة الإسرائيلية (Susan lee Hattis) نشرته في حيفا العام 1970، فقدمت له مراجعة موسعة في مجلة ("شؤون فلسطينية"، العدد 56، 25 نيسان 1976، ص 159-166) التي كان يصدرها المركز. والكتاب عبارة عن أطروحة دكتوراه قدمتها الكاتبة لدى جامعة جنيف للحصول على دكتوراه في العلوم السياسية، حيث استعرضت فيه تطور فكرة إيجاد دولة ثنائية القومية في فلسطين خلال الفترة من عام 1922-1948، من خلال عرض مواقف بعض الجماعات الصهيونية واليهودية وكذلك بعض الشخصيات الفلسطينية التي كانت تدعو لفكرة الدولة الثنائية القومية في فلسطين. ويتضح من خلال العرض المطول الذي قدمته الكاتبة أن فكرة دولة ثنائية القومية كانت محض خيال لأن الأطراف الفاعلة في الحركة الصهيونية كانوا يرفضون الوصول إلى أي اتفاق مع الفلسطينيين العرب يحد من قدرتهم على قيام دولة يهودية. وتورد الكاتبة ما ذكره في يومياته عام 1926 أحد أبرز الدعاة اليهود للدولة ثنائية القومية، آرثر روبين، "لقد وصلت إلى نتيجة، وهي أنه محكوم علينا أن نعيش في دولة بحرب دائمة مع العرب، ذلك أنه لا يمكن التوفيق بين حق العرب في وطنهم فلسطين وبين المشروع الصهيوني، وأي صيغ من هذا النوع، ستظل مجرد فكرة ومحض خيال، ولا يمكن أن تجد تطبيقها على أرض الواقع." كما تذكر الكاتبة أن موقف العرب "كان واضحا منذ البداية، فعلى الرغم من تنوع تكتيكاتهم، فقد بقي هدفهم واحدا، وهي أن فلسطين يجب أن تبقى عربية، وأن أكثر ما يتوقعه اليهود من العرب، هو قبولهم كأقلية ومنحهم حقوق الأقلية".
ويتضح من عرض الكاتبة أن دعاة الدولة الثنائية القومية من اليهود، ظلوا على هامش الحركة الصهيونية، ولم يستطيعوا أن يحدثوا أي تأثير ولو محدود على السياسة العامة للحركة الصهيونية، وأن الأشخاص الذين تبنوا هذه الفكرة، ظلوا هم أنفسهم من العام 1922 إلى العام 1948. وكذلك الأفراد أو الشخصيات الفلسطينية التي طرحت احتمالا أو توجها كهذا، كانوا أفرادا معزولين ولا تأثير لهم. هذا إذا استثنينا ما طرحته عصبة التحرر الوطني (الشيوعيون الفلسطينيون) حول فكرة دولة فلسطين الديمقراطية على كامل ارض فلسطين التاريخية أواسط الأربعينيات.
ولكن على الرغم إلى ما انتهت إيه الكاتبة من استحالة قيام دولة ثنائية القومية وتطبيقها على أرض الواقع، بحكم التعارض بين حق الفلسطينيين العرب في وطنهم فلسطين وبين المشروع الصهيوني، فإن فكرة دولة فلسطين الديمقراطية، دولة لجميع مواطنيها الذي يعيشون على أرضها، تظل إمكانية محتملة، في ظل عدم قدرة أي طرف، واقعيا، على نفي الطرف الآخر كليا. وهذا ما شجعني على مواصلة البحث حول موضوع دولة فلسطين الديمقراطية، والذي اعتبرته كأحد مشاريع بحثي الأساسية خلال عملي في مركز الأبحاث الفلسطيني.
بشكل عام، كان محظورا على أي إنسان فلسطيني أو غيره، أن يتحدث عن أي حل للقضية الفلسطينية دون التحرير الكامل والشامل وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 194. وكل من يتكلم أو يتحدث بغير ذلك يعتبر خائنا، وربما يٌقتل من بعض المتحمسين.
"التابو" الذي خلقناه نحن الفلسطينيين بشأن قضيتنا على مدى تاريخا الطويل، جمد فكرنا السياسي، وجمد حركتنا النضالية، وجعلنا نسير بقضيتنا دون أن نرى ما يدور ويجري حولنا من أحداث ووقائع مستجدة، قد تتطلب مرونة أو تغييرا في التكتيك أو الرؤية السياسية. إن الجمود السياسي والفكري في ظل واقع متغير، يضع أي حركة سياسية خارج إطار الفعل، ويعوق تطورها. ذلك من أبرز سمات القيادة السياسية حتى تكون فاعلة وتقود حركتها نحو النجاح وتحقيق منجزات، أن تتعامل مع المتغيرات التي تحيط بها بالواقعية الإيجابية (التحليل الملموس للواقع الملموس)، وأن تتحلى بالجرأة السياسية وعدم التردد في اتخاذ المواقف وانتهاج السياسات، التي تخدم حركتها ورؤيتها، حتى وإن كانت لا تحظى بالرضا الشعبي الكامل في حينه. وللأسف فإن هذا التابو لا يزال يسكن أعماق الكثيرين منا.
غازي الخليلي
سيرة وطن سيرة حياة
الحلقة الثالثة
(6)
الفكر السياسي الفلسطيني، إلى أين؟
بعد أحداث أيلول الدامية في الأردن جرى اعتقالي يوم 16/6/1971 في مخيم الوحدات في عمان، وصباح يوم 19/9/1973 غادرت معتقل الجفر الصحراوي، بعد اعتقال دام أكثر من 28 شهرا، مع من تبقى من المعتقلين الذين جرى اعتقالهم بعد أحداث أيلول الدامية. كنا ما يزيد على ألف معتقل، تكومنا في الباصات أو الحافلات، والتي زادت على العشرين. وانطلقت بنا الحافلات وأخذت تشق طريقها بنا مسرعة إلى آفاق الحرية، إلى الحياة. وهكذا أغلق معتقل الجفر الصحراوي أبوابه على قصص وحكايات، وذكريات وصور إنسانية، عن الصمود وعن العذاب والمعاناة.
الطريق الصحراوي من الجفر إلى عمان طويل. الصحراء تحف بنا من كل جانب كأنها بلا نهاية، الشارع الأسفلتي الطويل يمتد أمامنا طويلا كأفعوان يتلوى وكأنه بلا نهاية، أنظر في وجوه كل من حولي في الحافلة فأراها باتت تشرق بالحياة بالأمل. وبعد قليل من الوقت والأحاديث المتبادلة، ساد ما يشبه الصمت بيننا. فالجميع على ما يبدو أخذ يغفو بعد ليالٍ من السهد والترقب والقلق، وأنا أخذت عيوني يداعبها النعاس، ولكن ذهني ظل مستيقظا يستعيد ذكريات وأفكار عاشت معي خلال أيام سجني الطويلة.
لقد استيقظ وعيي منذ كنت طفلا مع نكبة فلسطين الأولى عام 1948 وما تلاها من أحداث وفواجع ألمت بنا كشعب. ونما وتطور ونضج هذا الوعي مع نكبة فلسطين الثانية في العام 1967، التي لم تكن أقل قسوة من النكبة الأولى، على الرغم مما أعقبها من أمل لم يدم طويلا. وما بين نكبة وأخرى كانت أفكاري ورؤيتي للأحداث تتطور، وأحيانا تتغير باتجاهات تتلاءم مع الوقائع والمتغيرات المستجدة.
أحداث أيلول الدامية عام 1970، لم تكن حدثا بسيطا في حياة الشعب الفلسطيني وحركة المقاومة الفلسطينية الناشئة. لقد كانت حدثا وجه ضربة قوية للحركة الفدائية إذ أفقدها القاعدة الأهم، التي تضم الجزء الأكبر من الشعب الفلسطيني خارج أرض الوطن، والتي كانت تنطلق منها إلى الداخل الفلسطيني. والتساؤل الذي شغل ذهني خلال وجودي في المعتقل هو: هل كان الصدام المبكر بين الحركة الفدائية وسلطة النظام الأردني حتميا، أم كان ممكنا تجنب هذا الصدام، أو على الأقل مد فترة التعايش أطول فترة ممكنة إلى حين يقوى ويتصلب عود الحركة الفدائية، بحيث تتبلور حالة من التكافؤ أو شبه التكافؤ في القوى بين الطرفين، تجعل من الصدام بينهما مكلفا لكلا الطرفين.
قد يرى البعض أن مثل هذا الاحتمال ليس ممكنا، باعتبار أن كلا الطرفين لا يمكن أن يتعايشا معا بحكم اختلاف وتناقض أهدافهما ومسارهما السياسي. بتقديري، أن هذا التقدير مبالغ فيه، إلى حد ما، وأن احتمالات التعايش فترة أطول، أو تجنب الصدام بالشكل المأساوي الذي حدث كان ممكنا، لو أحسنت الحركة الفدائية بكل أطرافها مسلكيتها العامة، ولم تفرض مبكرا سلطتها كسلطة موازية، وربما تفوق سلطة النظام، مما زاد من تأزيم النظام وتمكينه من حشد قوى لصالحه وتأليبها على الحركة الفدائية. بتقديري أن جزءا من المسؤولية تتحمله الحركة الفدائية، وبالأخص أطراف من يسار المقاومة الجديد، التي أججت بشعاراتها المتطرفة وممارساتها الفالتة من أية ضوابط، مثل خطف الطائرات وتوجيهها إلى مطار مستحدث في الأردن، وغيرها، شكلت بمجموعها عوامل زادت من اندفاع سلطة النظام نحو المواجهة والصدام، مدعوما برغبة قوى دولية، وعربية إلى حد ما. لقد وقفت ضد هذه الممارسات والسياسات الخاطئة، وحاربتها وانتقدتها في حدود إمكانياتي من موقعي القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
السجن، بالرغم من المعاناة التي يعيشها الإنسان في سجنه، ينشط الذاكرة ويبعث الذكريات قوية في ذهن الإنسان، وهي ذكريات يقتات عليها السجين وتعينه على الصمود. السجن بالنسبة لي، لم يكن فقط محطة للذاكرة والذكريات، وإنما كان بمثابة فسحة من الصفاء الذهني والعقلي للتأمل والتفكير، فيما مر بنا من أحداث، وما يمكن أن نواجهه في قادم الأيام.
أحداث أيلول الدامية ووفاة الرئيس جمال عبد الناصر التي أعقبتها بأيام قليلة، وقبل أن يُكمل مشروعه في إعادة بناء الجيش المصري لاستعادة الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة في حزيران 1967، شكلتا ضربة مضاعفة لحركة المقاومة الفلسطينية الناشئة. ذلك أن الرئيس جمال عبد الناصر، بالرغم من قبوله بمشروع روجرز "وزير الخارجية الأميركي" الذي رفضته حركة المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها وقادت حملة ضد الرئيس عبد الناصر لموافقته على المشروع الأميركي، ظل بمثابة الأمل بالنسبة للجماهير العربية ومحل ثقتها، وتحفظ له مواقفه الداعمة للمقاومة الفلسطينية، حتى وهي تشن حملة ضده، كما تحفظ له مواقفه القوية ضد العدوانية الإسرائيلية المتنامية، وشن حرب استنزاف ناجحة وفاعلة ضد القوات الإسرائيلية في سيناء. وما زاد الطين بلة، أن أنور السادات الذي خلف الرئيس عبد الناصر كرئيس لمصر "الجمهورية العربية المتحدة" آنذاك. لم يحز على الحد الأدنى من ثقة الجماهير العربية، وأفقدها الثقة بفعالية الجهد القومي العربي المقاوم ضد العدوانية الإسرائيلية وتحرير الأرض المغتصبة.
كنت خلال وجودي في المعتقل أتابع ما يصلنا من أخبار عن تحركات السادات ومحاولاته الدؤوبة للوصول إلى أتفاق جزئي مع إسرائيل لفتح قناة السويس، مقدمة لعقد صلح منفرد معها. وكنت ككثيرين غيري لا نثق بتلويحه المتواصل وتهديده إسرائيل بشن حرب ضدها.
لقد حاول أنور السادات أكثر من مره بعد سيطرته على الحكم في مصر، عقد اتفاق جزئي مع إسرائيل لفتح قناة السويس، ليكون بمثابة بداية لحل سياسي مع إسرائيل حول احتلالها لسيناء، إلا أن الحكومة الإسرائيلية بزعامة غولدا مائير وقياداتها العسكرية، الذين كانوا مأخوذين حتى الثمالة بما حققوه من انتصار سهل ومريح وغير مكلف في حرب حزيران، كانوا بكل غطرسة واستعلاء يرفضون حتى مجرد البحث في مثل هكذا مبادرات، ولديهم اعتقاد راسخ بأن الجيوش العربية التي انهزمت شر هزيمة في حرب حزيران، لن يجرؤ أي منها على شن حربا ضد إسرائيل.
كان السادات، الذي فشلت محاولاته ومبادراته لفتح مجرد حوار مع إسرائيل، قد أخذ في العام 1971 يعلن أن حربا لا بد منها مع إسرائيل، وتجرأ أواسط عام 1971 ليعلن أن عام 1971 هو عام الحسم، وإذا لم تتجاوب إسرائيل مع مبادراته سيشن الحرب عليها قبل نهاية العام.
كانت إسرائيل تتعامل مع إعلانات السادات عن الحرب وعام الحسم بالكثير من السخرية والهزء، وبخاصة أن العام 1971 مر دون أن يحدث أي شيء مما كان يعلنه السادات، والذي ادعى أنه لم يذهب إلى الحرب عام 1971 بسبب ما ادعاه من “ضباب" خيم على العالم باندلاع الحرب الهندية الباكستانية عام 1971، والتي أدت إلى انسلاخ باكستان الشرقية عن باكستان وقيام دولة بنغلادش.
في الحقيقة، تحول أنور السادات وادعاءاته بشن الحرب إلى أُضحوكة، وبخاصة بما أعلنه عن ضباب الحرب الباكستانية الهندية، ليس في نظر إسرائيل فقط، وإنما في نظر العالم وكل الشعوب العربية. وترسخ الانطباع لدى الجميع، أنه لا السادات أو غيره من الحكام العرب، لديه الجرأة أو الإمكانية لشن حرب ضد إسرائيل. ونامت إسرائيل على تقديرات أجهزة مخابراتها بأن لا حرب ممكنة أو محتملة، لا حاليا ولا في المستقبل، وأن هزيمة عام 1967 نخرت عميقا في جسد النظام العربي. وهذا ما طغى أيضا على الجميع، بمن فيهم القيادة الفلسطينية، التي أخذت تعيد بناء تشكيلاتها العسكرية وغيرها على الحدود اللبنانية المتاخمة لإسرائيل، في ضوء أن النظام السوري يُحكم قبضته على حدوده مع إسرائيل، لم يكن يسمح لأي كان من فصائل المقاومة القيام بنشاط عسكري في منطقة الجولان السورية المحتلة.
في ضوء كل تلك الأحداث والوقائع المستجدة بدأت أُدرك أن الخيار العسكري العربي لتحرير الأرض المحتلة عام 1967، بات بعيدا وربما لم يعد محتملا، وأن إعادة التفكير بما يجري واستخلاص العبر واشتقاق السياسات الواقعية لمواجهة ما يجري وما يستجد من أحداث، بات ضروريا.
لقد صعدت الوطنية الفلسطينية ونهضت في أوائل الستينيات مدفوعة بعجز النظام العربي عن التجسيد الحقيقي لما يرفعه من شعارات خادعة حول الإعداد لتحرير فلسطين، قامت أنظمة وسقطت أنظمة واحتل العسكر سدة الحكم بادعاء الإعداد لمعركة التحرير. تم قمع الشعوب العربية واضطهاد قواها الوطنية والتقدمية تحت يافطة التحرير، وامتلأت السجون والمعتقلات بالمناضلين من شيوعيين وتقدميين ووطنيين إعدادا للتحرير؟! وفي أول امتحان لهذه الأنظمة عند قيام إسرائيل بالشروع بتحويل مجرى نهر الأردن أواخر عام 1963 لإرواء النقب جنوب فلسطين، أرض المستقبل بالنسبة لإسرائيل، تكشف عجز النظام العربي عن الرد على ذلك. وتكشف بشكل فاضح في هزيمة حزيران عام 1967. والآن على الشعب الفلسطيني ممثلا بإطاره التنظيمي الجامع والقائد لحركة نضاله م.ت.ف، أن يستخلص العبر، ويعيد الإمساك بزمام قضيته، ويشتق السياسات والمواقف الواقعية، التي تحافظ على قضيته من الاندثار، أو عودتها لأشكال من الوصاية والإتباع، كما كان الأمر عليه قبل عام 1967.
(7)
بدايات تحول أولية في الفكر السياسي الفلسطيني
في شهر آب من كل عام يكون الجو شديد الحرارة، ويكون أقسى وأشد في المناخ الصحراوي، على الرغم من أنه ليلا يتجه نحو شيء من البرودة. جو متقلب في اليوم الواحد بين الحر الشديد والبرودة، كحال وضعنا ومصيرنا السياسي المتقلب باستمرار بين الأمل الشديد والخيبة.
كنا في معتقل الجفر الصحراوي نصحو عادة باكرا على حركة الغفير الذي يسلمنا مؤونة الخبز لليوم وفطور الصباح. بعضنا يمارس بعض التمارين الرياضية فور الاستيقاظ، للحفاظ على شيء من لياقته البدنية، ومنع الخمول من التسرب إلى عقله وذاكرته. بعد ذلك، نتناول في أغلب الأحيان فطورا جماعيا، يكون زاخرا بالمأكولات التي جلبها الزوار لأحبائهم من المعتقلين. ثم يتوزع الجميع، البعض يتجه إلى داخل البركس، يقرأ إذا توفر ما يقرأه، والبعض يلعب الورق أو الشطرنج، وبعض آخر يتمشى في باحة البركس، إما كأفراد يستعيدون خلال المشي بعضا من ذكرياتهم وأحوالهم الخاصة، أو كمجموعات صغيرة تتداول في بعض الأمور السياسية أو غيرها.
في يوم من أيام هذا الشهر الملتهب الحرارة عام 1972، كنت أتمشى لوحدي أستعيد بعض الأفكار التي شغلت ذهني حول وضعنا ومصير قضيتنا الوطنية بعد ما شهدناه من أحداث جسام خلال العامين الماضيين. لمحت وأنا أتمشى أحد الرفاق منزويا لوحده في إحدى زوايا باحة البركس، حانيا رأسه مسندا به على كف يده. تقدمت إليه، وباشرته بالسؤال:
ما بك يا رفيق هل هناك ما يزعجك؟
يبدو أنه تفاجأ باقتحامي خلوته. رفع رأسه ونظر إليَّ وقال بشيء من الحزن:
"لا شيء يا رفيق، ولكن منذ أيام لا أنام الليالي وأنا أفكر بمصيرنا، ليس كمعتقلين لأنه مهما طال اعتقالنا سنغادر هذا المعتقل البغيض، ما يقلقني ويؤرقني أن قضيتنا الوطنية باتت في مهب الريح، العرب لن يحاربوا على ما يبدو بعد وفاة الرئيس عبد الناصر، فالسادات بات أضحوكة الجميع بعد ادعاءاته الفارغة من أي مضمون عن الحرب، والمقاومة الفلسطينية تعاني من الحصار وتآلب الكثيرين عليها، من عرب وغيرهم، وإسرائيل تواصل قتل شعبنا والاستيلاء على أرضه وزرعها بالمستوطنين. بالَك يا رفيق في حل لقضيتنا، أم سنعود القهقرى إلى ما كنا عليه بعد نكبة العام 1948، مجرد لاجئين تلفظنا وتقسو علينا الأنظمة العربية، التي تاجرت بقضيتنا ومستقبل شعبنا."
كنت أصغي باهتمام شديد للرفيق وهو يتلو عليَّ ما يجول في ذهنه. وضعت يدي على كتفه وقلت له:
"ما بك يا رفيق، خلِّ ثقتك بنفسك وبشعبك قوية، فالصعاب أيا كانت لن تقهر إرادة الشعوب وهي تصمم وتكافح لانتزاع حريتها وحقها في الحياة وهذا مصير كل الشعوب التي نهضت للدفاع عن حريتها واستقلالها الوطني."
نظر إليَّ وشبه ابتسامة حزينة ارتسمت على محياه، وقال:
"أنا لم أفقد الثقة بشعبنا، ولكني أقول لك ما توصلت إليه بعد تفكير عميق، إن سلاحنا الأقوى في مواجهة هذا العدو المتغطرس، هو الحفاظ على شعبنا مقيما على أرضه الوطنية، وحيث يتواجد في المنافي والشتات، ضد محاولات إبادته كأننا من بقايا الهنود الحمر الذين أبادهم المستعمر الإنجليزي-الأميركي، أنا على يقين أن شعبنا حي وبات متمرسا على النضال، وإرادته في مواصلة النضال قوية وعالية مهما علت التضحيات. ومن أجل أن نبقى عصيين على الإبادة، يجب على شعبنا أن يكثر من النسل."
توقف قليلا ثم تابع حديثه وعلى شفتيه شبه ابتسامة: "يا أخي ليتزوج الواحد منا بدل الواحدة ليتزوج أربعة، (ابتسمت وهو يتحدث عن الزواج بأربع نساء) ويخلف منهن النسل الكثير، وذلك حتى نبقى شوكة كبيرة في حلوقهم، عصية على البلع، مهما قتَّلوا أو أبادوا منا. إسرائيل، بالرغم مما تلقاه من دعم دولي، وعربي مُبطن، لم يكن بإمكانها الصمود والبقاء على أرضنا، لولا السيل ال