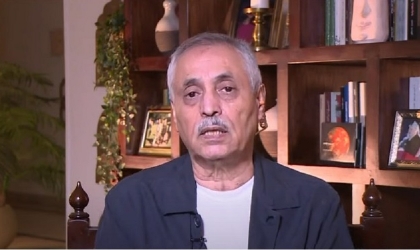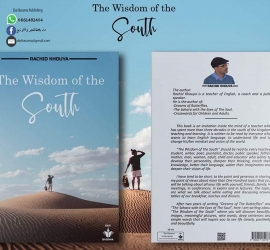
نصف ما تبقّى: رواية الغليان الأصلانيّ في الشرط الإسرائيليّ

مرزوق حلبي
أمد/ رواية 'نصف ما تبقى' لنيفين سمارة
من أفضل الإنتاجات التي قرأتها في السنوات الأخيرة. رواية ذكية مكتوبة بيد أجادت تحليل الراهن الفلسطيني في إسرائيل ـ إنها تفكيك لنفسيّة الفلسطيني ومعماره الداخليّ.
مرزوق حلبي :
كلّما نُشر خبر لجريمة قتل في واحدة من نواحينا تذكّرت رواية نيفين سمارة «نصف ما تبقّى» (الدار الأهليّة، 2021)، وكنت اطّلعت عليها وهي مخطوطة، ثمّ قرأتها روايةً متكاملة منحتني فرصة أن أرى مجتمعي على طاولة تشريح من 174 صفحة.
في القراءة الأولى للرواية، وهي في طورها الأوّل، مسّني هذا البريق في الكلمات والمعاني تحتها، في الرواية ومقولاتها. في المرّة الأخيرة الّتي قرأتها اقتنعت بالاستنتاجات الّتي خلصت إليها في عمليّة التشريح؛ فالمؤلّفة الّتي جاءتنا من حقل الطبّ شرّحت بعناية أوضاعنا، من خلال حكاية تقوم على أبطال موجودين في أوقاتنا وحاراتنا وبيوتنا. الأخ والزوج والأب والصديق والزميل في العمل والجدّة. أمّا أمكنتها فأوسع قليلًا، فهي البيت وبيت الجدّة والبلدة والمدينة اليهوديّة؛ حيث مكان العمل والقاهرة وبرلين وسواها؛ بمعنى أنّ المؤلّفة رأت مجتمعنا في امتداده من نقطة وجوده إلى الجوار وإلى البعيد؛ بمعنى أنّ الرواية منتشرة في أحداثها وشخوصها انتشار الواقع في المسافات كما سنرى.
توتّرات الرواية
في الرواية روايتان، والكثير من القصص الّتي تسند الرواية وتعمّق حفرها في الموجود الاجتماعيّ السياسيّ الثقافيّ؛ فهي عن أسرة من أسرنا في بلدة من بلدات الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة منذ عام 1948. حكاية أسرة من بداياتها في بلدة «الصابرة» حتّى ما آلت إليه، في الراهن، من تفكّك أو من انهيارات متراكمة. في رأسها الحدث الدراماتيكيّ؛ مقتل ابن الأسرة الشابّ أمير في إطار نزاع بين عصابات إجراميّة حول الحيّز والنفوذ. ثمّ طلاق ميسم من زوجها وليد، المحامي الشاطر والفرتيك الّذي اغتنى في برهة قصيرة؛ ليتّضح أنّه لم يكن محاميًا بقدر ما كان وكيلًا معتمدًا في تمرير صفقات العالم السفليّ، وتقاسم الموارد مع الفاعلين فيه.
حياة الأسرة من «الصابرة» هي حياة المجتمع الفلسطينيّ المعاصرة داخل ما يُصْطَلح على تسميته «الخطّ الأخضر»، على ما فيه من توتّر على جبهات عديدة، ولا سيّما التوتّر مع سيادة اليهوديّ الوافد حدّ التناقض...
أمّا الرواية الثانية فهي قصّة الودّ الّتي ربطت ميسم الطبيبة بعليّ، زميلها المصريّ، بدءًا بلقاء في مؤتمر طبّيّ في برلين، وانتهاءً بانهيار هذا الودّ الّذي يمكن تسميته بالحبّ المسدود مسبقًا على وقع أحداث «الربيع العربيّ»، والثورة المضادّة في مصر أساسًا وفي غيرها.
حياة الأسرة من «الصابرة» هي حياة المجتمع الفلسطينيّ المعاصرة داخل ما يُصْطَلح على تسميته «الخطّ الأخضر»، على ما فيه من توتّر على جبهات عديدة، ولا سيّما التوتّر مع سيادة اليهوديّ الوافد حدّ التناقض. التوتّر على جبهة العلاقة بسائر أجزاء شعبنا الفلسطينيّ؛ بسبب الفارق في المكانة السياسيّة بيننا وبينهم، كما صاغه النظام الإسرائيليّ في الوطن التاريخيّ لشعبنا. التوتّر اليوميّ على جبهة العلاقة باليهوديّ العاديّ في مكان العمل. التوتّر مع زميلها في المشفى، ومواقف زملائها في حالات الأحداث الدراميّة، ولا سيّما التصعيد في ساحة الصراع. التوتّر مع فضائنا العربيّ بوصفه عمقنا الإستراتيجيّ الثقافيّ والروحيّ.
شيء ما يُنهك الإنسان الفرد منّا، ويجعله في اختبار يوميّ في قراراته وفي محاولته البقاء والعيش والصمود. تؤسّس الروائيّة على نقطة الحاضر منطلقًا لروايتها، تبدأ ممّا آلت إليه أوضاعنا وأوضاع الأبطال لتقرأ الماضي وتستشرف المستقبل.
الرواية الأولى: حكاية الفلسطينيّ الّذي هنا
يمكننا أن نرى ذلك في حكاية ميسم، الّتي تأتي الرواية انطلاقًا منها، من سرديّتها هي ومن رؤيتها للأمر وعلى لسانها في مقاطع شعريّة شفيفة، ترسم فيها معمارها الداخليّ ومعمار الشخوص في الرواية. وهي ليست رؤية ميسم بقدر ما هي رؤية المؤلّفة الّتي خلقت ميسم وجعلتها تقول ما قالت. شخصيّة ميسم أساسيّة في الرواية، وهي مشاركة في أحداثها من داخلها، ورائية إلى أحداثها مقيّمةً متأمّلة، مستعدّة لأن تحكم على الأمور لا أن تصفها فقط، فيها من الجرأة أن تحلّلها وتخلص إلى استنتاجات وتفكيكات ذكيّة لمّاعة.
في ذلك تكمن أهمّيّة هذا العمل وقوّته؛ فهو حفر واعٍ في نفس الفرد الفلسطينيّ ونفس الجماعة في الوقت نفسه في راهنه، وهو محاولة إعلان فشل تجربتنا، فلسطينيّين داخل «الخطّ الأخضر»، في مستوى الاجتماع الّذي تفكّك وأنهكه العنف في مستوى الأسرة الصغيرة والبلدة والمجتمع والأحلام؛ فميسم الّتي راهنت على وليد شريكها خاب أملها تمامًا، لأنّ وليدًا كان مغايرًا في الحقيقة ومناقضًا له في الحلم. وميسم الّتي راهنت على «الربيع العربيّ» خذلتها الثورة المضادّة والعنف ونظام العنف. والأسرة الّتي رأت في أمير أصغرها وعدًا سرعان ما قتله شركاء له في الجريمة ذاتها. في كلّ هذه الخيبات لم يشفع لميسم سوى وعيها الفرديّ بحركة الانهيار وأسبابها ومآلاتها، وخلاصة تجربتها أنّ الطريق إلى الهدف هو الأساس.
نحن مأزومون وفق الرواية، في وجودنا أفرادًا وأُسَرًا وبلدة وجماعة وشعبًا وثقافة، أزمة وجوديّة ليست عابرة ولا تحلّ بالحيلة ولا بالوفرة الاقتصاديّة، فإمّا هي كاذبة مثل وفرة المحامي وليد وإمّا هي غير شرعيّة، كتلك الّتي حاول أمير أن يجمعها...
الرواية في مستواها الأوّل، حكاية الفلسطينيّ الّذي هنا، الأصلانيّ الّذي يسعى إلى العيش في شرط يضيق، رغم مظاهر البحبوحة والرخاء والوفرة، هي رواية الغليان الحاصل الّذي يقترب من مرحلة الانفجار. صحيح أنّ «الانفجارات» في الرواية داخليّة: السجن لأمير ثمّ مقتله، وطلاق ميسم وانكسارات الأسرة، وموت الجدّة، وعقم أحد أبنائها، وإعاقة لدى أحد المواليد، لكنّها تُنْذِر بانفجار أكبر على مستوى مواجهة الشرط السياسيّ والمؤسّسة الإسرائيليّة الضالعة بوعي تامّ في إنتاج هذا الشرط، وتضييق حدوده حدّ التفجّر السكّانيّ في «الصابرة»، بوصفها المكان الّذي تبدأ الرواية منها وتحدث وقائعها فيها.
نحن مأزومون وفق الرواية، في وجودنا أفرادًا وأُسَرًا وبلدة وجماعة وشعبًا وثقافة، أزمة وجوديّة ليست عابرة ولا تحلّ بالحيلة ولا بالوفرة الاقتصاديّة، فإمّا هي كاذبة مثل وفرة المحامي وليد وإمّا هي غير شرعيّة، كتلك الّتي حاول أمير أن يجمعها، وإمّا هي غير قادرة أبدًا على ردّ الأذى. أمّا العلاقات في وضع كهذا، كالعلاقات الخاصّة للمحامي وليد، فهي أيضًا، لا تصمد في امتحان الشدائد وفي الاختبار الوجوديّ، نكون أو لا نكون، فقد أخفقت في ردّ الموت عن وليد، وعن المئات من أفراد مجتمعنا في الحياة اليوميّة خارج الرواية.
الرواية الثانية: انتماء إلى «هناك» و«هنا»
على مستوى الرواية الثانية في الرواية، العلاقة المسدودة بين ميسم وعليّ؛ زميلها المصريّ، وهي علاقة ملتبسة لشريكيها وللمؤلّفة والقارئ. علاقة تبدأ في الغربة وفي مكان محايد هو أوروبّا، وفي هذا رمزيّة كبيرة، كأنّه لا يمكن العربيّ الفلسطينيّ هنا أن يقيم علاقة طبيعيّة مع عربيّ آخر في الإقليم، وأنّ الأرض المحايدة هي المكان لنموّ شعور إنسانيّ فطريّ قابل للحياة على نحو ما.
في هذه «الرواية» أيضًا، لا تسير الأمور بشكل أفضل منها في الرواية الأولى الرئيسيّة؛ فالعلاقة الّتي بدأت خفرًا وبحثًا عن «الأنا» المقابل هناك، الّذي يُرْجى أن يكون على قدر الحلم المعلّق عليه، لا تقوى على الوقوف. لكنّها تقوى على القول وتنجح فيه أيّما نجاح؛ إذ استطاعت المؤلّفة من خلال هذه العلاقة الملتبسة بين الطبيبة ميسم من «الصابرة» الّتي هنا، وبين زميلها المصريّ عليّ، أن تكشف الأفكار والمشاعر الّتي يحملها الفلسطينيّ الّذي هنا، المقطوع عن أمّته وثقافته في الإقليم؛ فقد نفذت إلى أعماقه من خلال تقنيّة الحوار المكثّف بين ميسم وعليّ، الّذي يمسّ جوّانيّة الإنسان في خلجاتها وبحثها عن المعنى، في شرط سياسيّ وجوديّ مُنْهِك.
ثمّة رغبة جامحة لدى الفلسطينيّ هنا للالتحام بأمّته الّتي كثيرًا ما بعثت عنده الخيبة بقدر ما بعثت الأمل. وهكذا «الربيع العربيّ» والثورة المضادّة الّتي أعقبته في مصر وسواها من أقطار، ثورة مضادّة حاصرت عليًّا في القاهرة، وقضت على أحلامه، وحاصرت في الوقت ذاته حلم ميسم بأن يتحقّق حلم عليّ؛ كي يتحقّق حلمها هي. تحليل مُحْكَم يرى إلى العلاقة الوثيقة بين «انتماء إلى هناك»، ينعكس بالتطابق على «انتماء إلى هنا» للثقافة والأمّة ذاتها. وطالما انعكست وقائع الإقليم العربيّ وأحداثه على الفلسطينيّين في «الصابرة»، بوصفها فلسطين.
كلّ شيء متحرّك
رواية نيفين سمارة هي في غايتها بوح ومكاشفة للذات، المأزومة في تفاصيل أزمتها وضائقتها الراهنة. تفعل المؤلّفة ذلك من خلال غوص شجاع في العوالم الداخليّة لها نفسها ولأبطالها؛ فأبطالها متعدّدو الأبعاد ينمون عبر صفحات الرواية وأحداثها، ويكبرون ويتبدّلون كما في الحياة. وهذا تحديدًا ما يمنحنا فرصة اكتشاف التعقيد الّذي في حياتهم ومآزقهم؛ فوليد يتغيّر وأمير أيضًا وعليّ وميسم نفسها وجدّتها الّتي تهرم وترحل، ليس قبل أن تروي رواية الأسرة وسيرتها. كلّ شيء متحرّك في الرواية، ولا سيّما اللغة الّتي تنزل إلى العمق؛ كي تأتي لنا بأثر الحياة في الشخوص، وبالندب الّتي تتركها في الأرواح؛ فهي ليست رواية الأحداث بقدر ما هي رواية أثر هذه الأحداث في روح الأفراد والجماعة. هنا، تظهر بوضوح قدرة المؤلّفة على الغوص في العمق، دون أن تُتعب القارئ وتنهكه. وكثيرًا ما يكون السرد المعمّق إشارات للقارئ بأن يلتقط البقيّة من الكلام الّذي لم تكتبه. في مقاطع كثيرة يكون الكلام نثرًا شعريًّا، يبثّ فنّيّة وجماليّة آسرة. هي كتابة تدعو القارئ إلى أن يتمتّع بذكاء عاطفيّ وجماليّ ولغويّ وسواه، ويقرأ.
رواية نيفين سمارة؛ موضوعنا، فهي رواية تفكيكيّة، في هذا هي ما بعد حداثيّة، تنقد الوضع وتشرّحه، ولا تعِد أحدًا من قرّائها بأيّ شيء سوى أنّها تشرّح وتشرّح ولا تخفي شيئًا عنه...
الرواية بأحداثها هي ديستوبيا تروي الخراب الّذي حلّ بنا. وهذا في حدّ ذاته أمر جدير بالاهتمام في ضوء روايتنا الأدبيّة هنا؛ فهي على العادة إمّا طوباويّة في مؤدّاها أو تترك باب الأمل مفتوحًا، كأنّنا على وعد شبه أكيد بالجنّة أو بالوطن أو سواه من فراديس مفقودة، على غرار الأفكار والعقائد السائدة عندنا، كلّها واثقة بنفسها، ولا تنفكّ تعدنا بالنصر أو الفجر أو الفرج في أقلّ تقدير. أمّا رواية نيفين سمارة؛ موضوعنا، فهي رواية تفكيكيّة، في هذا هي ما بعد حداثيّة، تنقد الوضع وتشرّحه، ولا تعِد أحدًا من قرّائها بأيّ شيء سوى أنّها تشرّح وتشرّح ولا تخفي شيئًا عنه.
تبدي المؤلّفة في روايتها قدرة هائلة في النفاذ إلى أعماق النفس البشريّة، فردًا أو جماعة، وتصوّرها من الداخل. صحيح أنّها تفعل ذلك من خلال شخوص الرواية الأساسيّين والثانويّين، وحواراتهم، وقصص سيرة أسرة واحدة، لكنّها استطاعت أن تصوّر من الداخل، بذكاء وفنّيّة، مفاعيل النكبة فينا، ندبها وآثارها المهلكة للروح والجسد على السواء.
كتبت لتقول بوضوح هذا هو الخلل في اجتماعنا ووجودنا. لم تستطع ميسم إنقاذ أحبّ الناس، ولا أن تهنأ بحلمها بوليد، ولا بالحلم التعويضيّ بعليّ، بل خسرت في كلّ هذه الاختبارات بالتراكم. كلّ ما فعلته هو أنّها روت لنفسها ولنا روايتها، وهي روايتنا كما هي. روت لنا قصّتنا من موقف عارف شجاع ونقديّ في التوجّه إلينا وإلى واقعنا الممسوس، وهو ما يحصل في الأدب عندما تكون المبدعة - والمبدع أيضًا - ذات رؤية ودراية ومعرفة تجعلها قادرة على التأمّل والاستنتاج، وإنتاج لغة لها تعيد الكرّة من حيث انتهت الحياة إلى انهيارات.